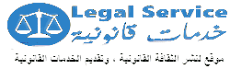تطبيق القصاص على الأب القاتل أو أب ولي القتيل وقواعد العدالة 
ا.د. أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب
أثارت حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة جدلاً قانونياً باعتبار أن المتهمين بالقتل هم أزواج لهم أبناء من ضحياتهم، مما يوجب عدم تطبيق القصاص استناداً إلى القانون الجنائي لسنة 1991، والذي نص في المادة (31) على أسباب سقوط القصاص عن الجاني ومن بينها (إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني). ويتعلق النقاش بمدى شرعية هذا النص من ناحية دينية وجواز الأخذ به، كما يتعلق بمدى عدالته حيث يفرق بين المكلفين بالقانون بسبب أن القتيل أو ولي القتيل فرع للقاتل.
من ناحية التشريع الذي تبنى هذه القاعدة فهو القانون الجنائي لسنة 1991. ورغم مرور ما يقارب ربع قرن من الزمان على تطبيقه إلا أنه منذ وضعه لم يجد حظه من الدراسة القانونية الكافية، كما أنه كان مشروعاً سياسياً وضعته الجبهة الإسلامية القومية خلال الفترة الديمقراطية الثالثة، وعند حدوث انقلاب عام 1989 تم إصداره دون تعديل يذكر على ذلك المشروع. ومن ثم فهو قانون يتسم بالصبغة السياسية لإضفاء مشروعية سياسية أكثر من كونه قانوناً مدروساً دراسة كافية ومتفق عليه حسب آليات تطبيق التشريعات في النظم المحترمة، كما أنه لم يستند على التجربة السودانية القانونية والقضائية، أو تتم دراسته وفق مراحل الدراسة الواجبة لتطبيق التشريعات. ولم يحظ القانون السوداني لسنة 1991 طوال ربع القرن الذي عاصر تطبيقه بقياس أثر يحدد مدى جدوى كثير من مضامينه ومقتضياته التي اشتمل عليها.
الأصل في تطبيق قاعدة القصاص ما ورد في عدد من الايات الكريمات من بينها (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) و (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). ويتضح أن الآيات التي تعرضت للقصاص اتسمت بالعمومية ولم تذكر استثناء يفيد سقوط القصاص في حال كان القتيل ولد للقاتل، أو كان ولي القتيل فرعاً للجاني.
يذهب كثير من الذين يؤيدون قاعدة سقوط القصاص إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني، إلى تأسيس القاعدة على الحديث النبوي (أنت ومالك لإبيك) باعتبار أن الابن هو صاحب ولاية الدم ومن ثم فان الاب صاحب حق مما يخلق شبهة تسقط القصاص. وذهب بعض فقهاء الشريعة إلى تأسيسه على الحديث النبوي (لا يقاد والد بولده). وبالطبع فإن كلا الحديثين لا يمكن الاستناد إليهما بقناعة كاملة على أساس أنهما يمثلان نصاً دينياً محكماً في حال كان ابن القتيل فرعاً للقاتل، وإنما هي تخريجات بعض الفقهاء تتسم بضعف المنطق وعدم وجود نص مباشر للدلالة على تلك القاعدة. ومن ثم فإنها لا تستحق القدسية الدينية التي يحاول بعض الكتاب إلى إضفائها عليها. بل إن هذه القاعدة تخالف أراء فقهاء عظام مثل الامام مالك الذي ناقش القصاص في حق الوالد عند قتل ابنه المباشر وليس أم ولده فقط فقال (لا يقاد الوالد بابنه إلا أن يضجعه فيذبحه ، فأما إن حذفه بالسيف أو عصا فقتله لم يقتل به. وإن ذبحه أو قتله قتلاً لا يشك أحد في أنه عمد إلى قتله لم يقتل به) ويتضح من قول الإمام مالك أن سقوط القصاص عن الاب إذا قتل ولده لا يسقط في كل الأحوال تلقائياً وإنما في الأمر نظر من بينه حالة كان القتل عمداً.
من ناحية تاريخية فإن القانون السوداني لم يكن يمنح الوالد القاتل حق الاستفادة من الابوة لدفع تنفيذ عقوبة الإعدام عليه إذا كان القتل عمداً، ففي قضية حكومة السودان (ضد) عبد الله مرعي محمد المنشورة بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1970 كان المتهم من أحد أرياف مدينة الدويم، وأراد أن يزوج ابنته إلى ابن أخيه ولكن البنت وأمها عارضتا ذلك الزواج بحجة عدم الكفاءة، وسبق أن رفضت البنت خطيبين قبله مما أثار حفيظة الأب، فتوعد البنت، وعند منتصف الليل سدد لها ثلاث طعنات قاتلة أودت بحياتها، بعد أن أسعفت في اليوم التالي للحادثة في مستشفى الدويم. وقد توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم بالقتل العمد، وفق المادة 251 من قانون العقوبات لسنة 1925. وأعد محامي القاتل مرافعة دفاع مليئة بالعاطفة الدينية ركزت على موضوع واحد هو الحديث النبوي (لا يقاد والد بولده) دون الإشارة إلى حالات عدم تطبيقه أو اختلافات النظر عند تطبيقه فذكر للمحكمة: (قال الرسول الكريم "لا يقاد الوالد بولده" وأنه أعدل البشر وهو في درجة علمية وفقهية وتشريعية لا يصل إليها أحد من البشر وهو أعلم من جميع البشر بأصول العدل وموثوق فيه لا يظلم. وهو أعلم بعلل الأحكام فعندما ساق هذا الحديث كان يعلم بعدله وحاشاه أن يظلم الابن لوالده وأن تجاهل هذا الحديث الشريف الموثوق به والمجمع عليه يمس الامة في أقدس مقدساتها وفي أعظم شخص من شخصياتها وأن الأصل أن الأب هو السبب في وجود الابن أو البنت) وعلى هذا الأساس تفادت المحكمة تطبيق حكم الإعدام، وأنزلت على المتهم عقوبة السجن المؤبد. وعند رفع الحكم إلى المحكمة العليا أيدت قرار إدانة المتهم بالقتل العمد، لاعترافه بجرمه ولوجود شهود عيان على ذلك، كما أن المتهم سليم العقل ولا يوجد ما يدل على اضطراب في قواه العقلية أو داعي قد يخفف الإدانة بجريمة القتل العمد. ولكن توقفت المحكمة الأعلى في العقوبة التي حددتها محكمة الموضوع بالعدول عن تطبيق حكم الإعدام. واستقر رأيها أن الحكم بالسجن المؤبد عوضا عن الاعدام ليس من اختصاص محكمة الموضوع، ومن ثم أمرت بإعادة الأوراق مرة أخرى لمحكمة الموضوع للحكم بالإعدام كما حدد القانون وأوضح، ولها أن توصي للجهات المختصة بتخفيف الحكم إلى الحبس المؤبد.
في تقديري أن ما كان وارداً بموجب قانون العقوبات لسنة 1925 أكثر عدالة وهو عدم صلاحية المحكمة الابتدائية في العدول عن الحكم بالإعدام أو تطبيق السجن ، وعدم صلاحية المحكمة الابتدائية لاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن ، فليس لها الخيار بغير الحكم بالإعدام، فإذا رأت أن هناك أسباباً تدعو للرأفة فإنها تحكم بالإعدام ومن ثم ترفع توصية للسلطة الأعلى فهذا يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي، ويفتح الباب أمام الموازنة بين تشديد العقوبة أو تخفيفها طبقاً لتعمد القاتل.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات