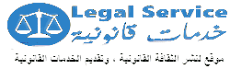مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان (6)
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
(Eltayeb2hussein@gmail.com - Eltayeb.hussein@yahoo.com
مهما قيل أو يقال عن الحكم الثنائي البريطاني المصري في السودان 31 ديسمبر 1899م – 01 يناير 1956م، إلا إنه حقق أربعة أشياء للسودان:
(1) تحصل السودان على تقرير المصير الذي أدى إلى الإستقلال.
(2) بناء خدمة مدنية مدربة ذات مستويات عالية من المسئولية والأمانه.
(3) تطبيق وتنفيذ حكم القانون الذي ينطبق على كل الأفراد، ولا تتدخل السياسة فيه.
(4) منع الأطماع الاجنبية والإحتفاظ بالسودان للسودانيين.
وجغرافيا وشعب السودان السياسي الحديث، موروث الجغرافيا والتاريخ المنحدر من الحضارة الكوشية، مرجعيته التاريخية السياسية الدستورية هو وثيقة إتفاقية معاهدة 07 / 09/ 1877م (الاحتلال التركي المصري للسودان)، ومعاهدة الحكم الثنائي البريطاني المصري 10 /07 / 1899م المعدلة 1936م كأول دستور للسودان، لاعتبارة دستور منحة للسودانيين لحكم السودان، وعلى أساسه تأسست البنى المؤسسية والاجتماعية للسودان الحالي. إذ بموجب معاهدة حكم السودان 07 /09 / 1877م (الاحتلال التركي المصري للسودان)، إعترفت بريطانيا بإمتداد إقليم السودان شرقاً إلى البحر الأحمر وغرباً إلى دارفور، وجنوباً حتى حدود أوغندا.
وبموجب إعتراف بريطانيا بحدود السودان التركي المصري 07/ 09/ 1877م، ومعاهدة الحكم الثنائي 10 /07/ 1899م المعدلة 1936م، تشكلت جغرافية السودان السياسي المعاصر بحدوده الحالية، وتشكل تعريف هوية إسم السودان السياسي 01/ 01/ 1956م. لأن معاهدة حكم السودان البريطاني المصري ضمن نصوصها عرفت كلمة السودان في المادة الأولى، بأن كلمة السودان تشمل كل المناطق الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة، وهي المناطق التي لم تدخلها القوات الإنجليزية المصرية، وأيضاً المناطق التي كانت تُحكم بواسطة الخديوي محمد علي باشا ملك مصر، وفقدت السيطرة عليها، ثم إستعادتها بواسطة القوات البريطانية المصرية معاً في 31 ديسمبر 1899م، وتشمل أي مناطق أُخرى يتم إستعادتها بواسطة الدولتين من بعد التمرد الأخير(وحيث عبارة كلمة التمرد الواردة في معاهدة حكم السودان الانجليزي المصري) معني بها ثورة اللواء الأبيض عام 1924م ومن قبلها مناهضة سلطة الحكم البريطاني المصري في غرب السودان، بإخضاع دارفور عام 1917م لسلطة الحكم البريطاني المصري على السودان، نتيجة تأثير النفوذ الوطني للزبير باشا رحمة والسلطان على دينار.
وأن أول برلمان في السودان (سلطة تشريعية) هو المجلس الإستشاري لشمال السودان المنشأ بالقانون رقم 36/1943م بتاريخ 15 / 05 /1943م برئاسة الحاكم العام البريطاني وعضوية السكرتير الإداري والسكرتير القضائي والسكرتير المالي، ومجموعة نخبة صفويه محدوده من الأعيان والزعماء السودانيين أعضاءاً، يعينهم الحاكم العام. وبمقتضى القانون 36/1943م يختص المجلس الاستشاري بتقديم المشورة والرأي للحاكم العام، فيما يعرض على المجلس من أعمال، وهي مشورة غير ملزمة، ولاحقاً تأسيس الجمعية التشريعية لسنة 1948م نتيجة ضغط مؤتمر الخريجين 1936م (وللمهتمين والمختصين، يلاحظ في تشكيل المجلسين التشريعيين، تغول وسيطرة السلطة السياسية من الحاكم العام والسكرتير الاداري والسكرتير المالي والسكرتير القضائي على أعمال المجلس الاستشاري 1943م والجمعية التشريعية 1948م).
وأن أول وثيقة بمثابة دستور مكتوب، وبمقتضاها نال السودان إستقلالقه من الاستعمار الانجليزي المصري على السودان، هي إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بتاريخ 12 فبراير 1953م. ووقع عن الحكومة المصرية اللواء أركانحرب/ محمد نجيب (رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1953م المصرية وقتئذ)، ووقع عن الحكومة البريطانية السير/ رالف ستيفنسون (السفير البريطاني في مصر). وحيث من تاريخ التشريع في السودان إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 12 فبراير 1953م واقعة قانون مفقودة في سياق سرديات تاريخ التشريع في السودان لحقبة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان 31 ديسمبر 1899م – 01 يناير 1956م، والمتداول الذي يُردد هو قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 21 مارس 1953م، وليس إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 12 فبراير 1953م الموقعة بين الحكومتين البريطانية والمصرية.
وتفصيلات ذلك، أنه بموجب وثيقة إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 12 فبراير 1953م، صدر قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 21 مارس 1953م بمسودة القانون المحررة بتاريخ 02 أبريل 1952م مشروع قانون، الذي أعده المستر/ ستانلي بيكر قاضي المحكمة العليا بالخرطوم، وقدمه المستر/ جيمس روبرتسون السكرتير الإداري بتاريخ 02 أبريل1952م للجمعية التشريعية 1948م، ومن مرحلة القراءات التشريعية لمسودة مشروع القانون والموافقة عليه من الجمعية التأسيسية 1948م، قام المحامي العام/ جاك مافروفرداتو بمفردة بصياغته.
ومن ثم بتاريخ 08 مايو 1952م تم إحالة مسودة مشروع قانون من الحاكم العام للسودان السير/ روبرت هاو إلى الحكومتين البريطانية والمصرية، لإبداء ملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون، وإعادته للحاكم العام للسودان بملاحظاتهم خلال مهلة محدده ستة شهور. والذي تم هو التوقيع على إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 12 فبراير 1953م، ومن ثم وفقاً لنصوص إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 12 فبراير 1952م، تمت المصادقة من الجانبين البريطاني والمصري بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون المعدّ 1952م، ومن ثم إصدار قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان في 21 مارس 1953م كنصوص تشريعية تبعية تكميلية لإتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان الصادرة بتاريخ 12 فبراير 1953م.
وتبعاً للسياق التاريخي الدستوري في السودان، توقيع قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 1953م، وإصداره قانون في القاهرة بتاريخ 21 مارس 1953م جاء نتيجة مباشرة للملاحظات التي قدمتها الحكومتان البريطانية والمصرية حول مسودة مشروع القانون التي أحالها الحاكم العام في 08 أبريل 1952م. وقد خضعت مسودة مشروع القانون للمراجعة والنقاش المشترك بين الطرفين خلال الفترة الممتدة من تاريخ يوم 15 أغسطس 1952 إلى 12 فبراير 1953م. وبموجب الاتفاقية والقانون المترتب عليها، بدأت فعلياً مسيرة تأسيس وتشكيل البنى الهيكلية للمؤسسات السياسية والدستورية للدولة السودانية 01 يناير 1956م -- 19 فبراير 2025م تاريخ الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م(تاريخ صدور ونشر تعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019م).
من السرديات التاريخية والدستورية للدولة السودانية، الحقبة الزمنية التاريخية الممتدة بدءً من فترة الحكم الثنائي وحتى الاستقلال، يشكل إطار سياقي تأسيسي ذا طابع تاريخي وفلسفي يحمل في أحشائه التوجهات الفكرية لإدارة السلطة في السودان، التي على ضوئه تشكلت معالم الدولة السودانية الحديثة. وتمثل المرحلة خلفية ضرورية لفهم طبيعة بنية الدولة السودانية ومؤسساتها، وتتبع مسارات تطورها لحقبة الحكم الوطني المضطرب وغير المستقر، وصولاً إلى المرحلة الراهنة. وكما شكلت النواة الفكرية والقانونية التي انبنت عليها مؤسسات الحكم والدستور والقضاء في السودان الحديث. وللمزيد راجع في ذلك: فريق شرطة حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، التشريع وصناعة القانون (المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، المؤسسة العربية المتحده للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى، 2025م.
وللتوضيح، الفلسفة والتوجهات الفكرية المؤسسة لبنى أبنية الدولة السودانية الحديثة، نشير لها دونما إسهاب أو إختزال مخل، إشارة لها من حيث الآتي:
(أولاً) فكرة الدولة الحديثة المرتبطة بالاستعمار الإداري:
السودان لم ينشأ على نمط دولة تقليدية أو دولة وراثية ذات نظام سياسي إداري مستمر تاريخياً دون إنقطاع، إنما نشأ كيان سياسي إداري بيروقراطي في سياق سلطة الاستعمار الثنائي البريطاني– المصري 31 ديسمبر 1899م – 01/ 01/ 1956م. وتبعاً لذلك، لم تنشأ الدولة السودانية الحديثة على خلفية تقاليد ملكية متوارثة أو مؤسسات سلطات إدارية محلية قومية متجذرة.
وللتوضيح، على سبيل المثال، المغرب مثال لأنموذج دولة ملكية وراثية تقليدية، فقد أسس ملكيتها الأسرة العلوية، وظلت الأسرة العلوية، دون إنقطاع تاريخي زمني مستمر تحكم المغرب منذ القرن السابع عشر الميلادي، وكما ظل النظام السياسي في الدولة متصل تاريخيًا دون إنقطاع. وكذلك المملكة العربية السعودية أنموذج لدولة ملكية وراثية حديثة (ملكية وراثية دينية تحالفيه)، قامت على تحالف بين أسرة آل سعود والمؤسسة الدينية الوهابية منذ القرن الثامن عشر، وظلت ملكية، لكن تقليدية في أصلها.
ومثال آخر، المملكة العربية الأردنية الهاشمية، ملكية هاشمية وراثية، وأسس ملكيتها أسرة هاشمية أتت من أرض الحجاز من الجزيرة العربية(المملكة العربية السعودية حالياً). وتم تأسيس أمارة بني هاشم بترتيب مع بريطانيا، فهي توصف بأنها دولة معطاة مفروضه من الخارج، لكنها احتفظت بنظام وراثي عربي تقليدي مستقل عن بريطانيا، وظلت ناشئة دولة مؤسسات إدارة وسلطة في سياق سياسي مستمر بعيداً عن بريطانيا. وأيضاً سلطنة عُمان، نشأت وتأسست دولة لسلطنة وراثية لأسرة البوسعيد، وظلت الأسرة تحكم منذ القرن الثامن عشر الميلادي. وكمثال أيضاً دولة إثيوبيا الفيديرالية الحاليه، ظلت وحتى 1974م ملكية وراثية دينية، وملكيتها الوراثية بزعم أسطوري بإنحدار وراثة الملك (الحكم) من سلالة الملك النجاشي على زعم إنحدار الملك النجاشي من سلالة الملك سليمان (نبي الله عليه السلام).
وأخيراً الدولة المصرية، فقد نشأت في سياق الجغرافيا والتاريخ السياسي، دولة تاريخية ذات جذور حضارية، وليست مجرد جغرافيا مرسومة باتفاقيات دولية، بل إنما نشأت من سياق حضاري – سياسي – ديني متصل منذ آلاف السنين. ورغم تعاقبت على مصر أنظمة حكم متواصلة لحقب زمنية مختلفة ومتعددة، إلا الدولة المصرية ظلت محافظة على مركز سياسي حاكم في وادي النيل عبر أغلب العصور. وظلت دولة قائمة لها مؤسسات إدارة وسلطة وسكان وهوية جغرافيا وشعب قومي.
وبمعايير خلفية الملكية المتوارثة أو السلطة المحلية القومية المتجذرة والمستمرة تاريخياً دون إنقطاع، السودان دولة معطى ومفروضة من الخارج. ومثل السودان على سبيل المثال، دولة العراق وسوريا ولبنان ونيجيريا والكونغو وليبيا ودولة جنوب السودان. فقد تأسست دولة السودان الحالية على فلسفة الإدارة الحديثة التي جلبها الحكم الثنائي البريطاني – المصري، والتي هدفت إلى ضبط شئون الإقليم وفق منطق الدولة / المكتب State as an administrative apparatus لا الدولة / ذات السلطة التاريخية المستمرة دون أنقطاع زمني. وخلاصة القول، الدولة التقليدية / الوراثية، تنشأ من تواصل سلطة محلية أو عائلية، تكتسب شرعية تاريخية / دينية / اجتماعية، وتؤسس شرعيتها على الاستمرارية والقرابة دونما إنقطاع. ومقاربة مع دولة السودان، نجد أن السودان، نشأ دولة حديثة، مقطوعة الجذور السياسية المحلية، ومبنية على نظام إداري استعماري، لا يستند إلى تراث سلطوي محلي مستمر.
ومن السياقات السردية عن نشأة السودان الحالي، المقصود بالسودان دولة معطى ومفروضة من الخارج، أن السودان كما نعرفه اليوم بحدوده، ومؤسساته، وهويته السياسية، لم ينشأ عن سلطة محلية متواصلة تاريخيًا كملكية أو سلالة حاكمة أو زعامة وطنية موحدة. بل نشأ بوصفه كيان إداري حديث، أوجدته قوى استعمارية - بريطانيا ومصر- عبر اتفاقيات دولية، وتنظيم بيروقراطي مفروض من الخارج. ومن السياق التاريخي الدستوري والسياسي للدولة السودانية الحالية، دلالة المفهوم السياسي للدولة الحالية، صارت واصبحت الدولة تتميز بالآتي:
(1) لا يوجد تاريخ دستوري داخلي متصل في السودان، يربط الحاضر بالماضي عبر نظام حُكم قومي أو ملكي مستمر، دون ما أنقطاع تاريخي زمني.
(2) بناء مؤسسات الدولة السودانية الحديثة جاء مستورداً ومعطى بفرضه من الخارج، ولم ينبثق عن إرادة شعبية داخلية، بل عن سياق إداري/ استعماري فرض إطار الدولة من أعلى.
ومن أبرز ملامح الفلسفة الإدارية المعطاة من الخارج على الدولة السودانية، التنظيم الإداري البيروقراطي للسلطة، وأبرز ملامحه الآتي:
(1) جرى تقسيم الدولة إلى مديريات(مدير المديرية أو المحافظة)، ومراكز(مفتش المركز من الضباط الإداريين)، وعلى رأس كل من الديرية أو المركز مسئول تابع مباشرة للحكومة المركزية (الحاكم العام).
(2) التنظيم البيروقراطي الاداري فيه كل وظيفة محددة بدقة، وتخضع لتراتبية إدارية صارمة، تضمن الانضباط والفعالية، لا المشاركة الشعبية.
(3) إتباع نظام التسلسل الهرمي للسلطة والإدارة على نمط السلم من الأعلى إلى الأدنى، حيث يصدر القرار من رأس القمة في الخرطوم مركز القرار والتخطيط، وينفّذ على الأرض دون مشاركة فعلية من السكان المحليين في صناعته.
وقد عزز هذا التسلسل الإداري البيروقراطي للسلطة، سيطرة الدولة المركزية في الخرطوم، لكنه همّش وتجاهل السلطة التقليدية والتمثيل المحلي للهامش من المركز، بتهميش الأطراف(دارفور، الجنوب، الشرق) اقتصاديًا وسياسيًا. وصناعة نخب وصفوة نيلية في الشمال والوسط، وتوظيفها لخدمة مصالح النظام البريطاني المصري.
والنتيجة لاحقاً، المركزية الشديدة أضعفت فرص بناء وحدة وطنية متوازنة، وأسهمت في إفقار الهامش من المركز اجتماعيا واقتصاديا، ونشوء التهميش والتمرد المستمر والمتلاحق على سلطة المركز. وبالتالي، المحصلة النهائية، تنمية وتغذية إستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي الحرج، المستمر الذي يعيش عليه السودان الحالي.
(4) نظام السلطة المركزية التراتيبي البيروقراطي، أخذ بنظام القانون المكتوب Codified Law، بإدخال أنظمة قانونية مستمدة من النموذج الإنجليزي (القانون العام) المستورد من بريطانيا، وفرضه على المجتمع المحلي، ونُظّمت المحاكم والشرطة (البوليس) والسجون والتشريعات بطرق مهنية. وهذا مكّن من ترسيخ مفهوم سيادة القانون، لكن ضمن بيئة تفتقر إلى التمثيل الديمقراطي أو الرقابة المجتمعية.
هذه الفلسفة الإدارية للسلطة، نجحت في تأسيس جهاز دولة بيروقراطي فعال نسبيًا، لكنها:
(1) تجاهلت البُعد السياسي والمجتمعي في تكوين الدولة.
(2) خلقت دولة قوية إداريًا، ولكنها ضعيفة اجتماعياً.
(3) جعلت الشرعية السياسية للدولة مستندة إلى النظام والانضباط، لا إلى التمثيل والمشاركة.
وقد أدى كل ذلك، بعد الاستقلال والحكم الوطني، إلى أزمة عميقة في بناء الدولة الوطنية، إذ ورثت النخبة السودانية، هيكلاً إداريًا صلباً، لكنه فارغ من الداخل سياسيًا وشعبيًا، مما أدى إلى؛ توالي الانقلابات، وهشاشة الدساتير، وضعف الاستقرار السياسي.
(ثانياً) هيمنة الفكرة الإمبريالية الليبرالية:
ومقصوده بمعنى هيمنة الفكرة الإمبريالية الليبرالية في الحكم الثنائي، فرغم الطبيعة الاستعمارية الكولونيالية لسلطتي الحكم البريطاني - المصري في السودان 1899م – 1956م، والتي قامت في جوهرها على الاحتلال والسيطرة الأجنبية، إلا أن الحكم الثنائي لم يكن مجرد سلطة قمعية كلاسيكية، بل اتخذ – ولو شكليًا – بعض ملامح الدولة الليبرالية الحديثة، المستمدة من التراث السياسي الغربي. ومن أبرز تلك المظاهر:
(1) فصل السلطات (نظريًا)، بإقرار مبدأ فصل السلطات من حيث الشكل المؤسسي، إذ جرى التمييز بين الإدارة المدنية والقضاء، مع تقليد لبعض المؤسسات التشريعية والإدارية.
(2) حيادية الخدمة المدنية، بتبنّي نموذج الخدمة المدنية المحايدة، بوصفها جهازاً إدارياً، يفترض فيه الكفاءة، والابتعاد عن الولاءات الحزبية أو الطائفية.
(3) سيادة القانون دون تحزّب، بإعلاء مبدأ سيادة القانون، حيث بُنيت المحاكم وفق نماذج قانونية حديثة، وصدرت تشريعات ذات طابع موحّد، تحكم علاقة الفرد بالمجتمع والدولة. لكنه في الواقع مارس سلطة أبوية فوقية، تُشرك السودانيين بصورة محدودة جدًا في الحكم.
غير أن هذه المبادئ، ورغم أهميتها في رسم ملامح الشكل المؤسسي للدولة، لم تُطبّق باعتبارها حقوقًا سياسية للسكان المحليين، بل استُخدمت كأدوات ضبط وسيطرة إمبريالية. فالحكم الثنائي ظل يمارس:
(1) سلطة أبوية فوقية، ترى في نفسها وصية على السودانيين، وتعتبرهم غير ناضجين سياسيًا.
(2) إشراكًا محدودًا ومراقباً للسودانيين في الحكم والإدارة، غالبًا عبر وسطاء تقليديين(زعماء قبائل، طوائف دينية)، ضمن إستراتيجية الحكم غير المباشر الـ Indirect Rule.
(3) إقصاءً ممنهجًا لأي تمثيل شعبي فعّال أو مسار ديمقراطي حقيقي، إلى أن فرضت التحولات العالمية (لما بعد الحرب العالمية الثانية)، تبني بعض أشكال المشاركة السياسية تدريجيًا
فقد مثّل الحكم الثنائي نموذجاً لليبرالية الإمبريالية، التي تجمع بين: الخطاب القانوني والإداري الليبرالي، والممارسة الاستعمارية الهرمية. وهو ما أنتج دولة حديثة في شكلها، لكنها فاقدة للمحتوى الديمقراطي والاجتماعي الحقيقي، وهو ما انعكس لاحقًا في أزمة الشرعية السياسية للدولة السودانية المستقلة، التي ورثت هذا البناء دون القدرة على ملء فراغه الداخلي.
(ثالثاً) التحول التدريجي نحو الحكم الذاتي:
رغم طابع الحكم الثنائي القائم على السيطرة، بدأت منذ ثلاثينيات القرن العشرين تحولات سياسية تدريجية نحو منح السودانيين بعض أدوات المشاركة في الحكم الذاتي. وكان ذلك نتيجة عوامل متراكبة ومتراكمه، أبرزها، ثورة 1924م التي دشّنت لأول مرة مواجهة عسكرية مسلحة مباشرة للمشروع الاستعماري. وتأسيس مؤتمر الخريجين 1937م، كأول تنظيم مدني حديث طالب بإشراك السودانيين في الشأن العام.
لكن فلسفة منح السودانيين الحكم الذاتي، لم تكن نابعة من إيمان المستعمر بحق تقرير مصير السودان وتقرير المصير للسودانيين. بل كانت، فلسفة براغماتية دفاعية، هدفها احتواء ضغط الحركة الوطنية المتناميه ضد المشروع الاستعماري في السودان. وإستراتيجية مرحلية، لحماية المصالح الاستعمارية عبر نقل السلطة تدريجيًا إلى نخب مدنية موالية نسبياً أو قابلة للتطويع.
(رابعاً) الهوية السياسية الموروثة:
تشكلت الهوية السياسية للدولة السودانية الحديثة على أساس حدود سياسية رسمها الاستعمار، لا على أساس وحدة ثقافية أو وطنية داخلية. فقد استند تكوين الدولة إلى اتفاقية الحكم الثنائي 1899م، التي عرّفت السودان كوحدة إدارية تخضع لسيادة شكلية مزدوجة بريطانية - مصرية. وكما إستندت هوية السودان على تعريف خارجي للهوية السياسية، بمعزل عن التكوينات الاجتماعية والثقافية للسكان.
ما أدى إلى ما يمكن تسميته بـالانفصال الرمزي بين الدولة والمجتمع الـ Symbolic Disconnection between State and Society، أو بصيغة أخرى أكثر شيوعًا في الأدبيات السياسية والاجتماعية الـ Symbolic Detachment of the State from Society، أو أحيانًا يُستخدم التعبير بصيغة تحليلية بعبارة الـ Lack of Organic Link between the State and Society. ونتج عنه لاحقًا، صراع طويل بين المركز والهامش، وأزمة تعريف للهوية الوطنية، هل هوية عربية / أفريقية؟ أم هوية إسلامية/ مدنية؟ دونما إعتبار تبني مشروع رابط نواة الهوية الـ Core Identity للسودان الحالي، الهوية المتجذر أرضاً في الكوشية الـ Cushiest أو الـ Cushism الجنس الكوشي الحضاري المنحدر منه حضارة نبتا (نوباتيا) والحضارة المرورية (مروي). وكما أدى لتفكك في الولاءات السياسية والجهوية، وتنامي الانتماء الجهوي الحمائلي الإثني القبائلي على الهوية الجمعية الوطنية.
وللتوضيح، يشير مصطلح الكوشيزم Cushism إلى هوية حضارية متجذّرة في الإرث الكوشي القديم بوادي النيل، بما يشمل المكونات الثقافية والسياسية والرمزية لمملكتي نبتا (نوباتيا) ومروي. ويعبّر المفهوم عن انتماء تاريخي متأصل في الأرض، يقوم على البنية الكوشية الأصلية للحضارة السودانية، بما يُمثّل سردية بديلة للهويات القومية المصطنعة أو المفروضة في سياق ما بعد الاستعمار، الطارح لمفهوم مصطلح السودانوية الـ Sudanism طريحة الأفريقانية(الأفرقة) والعروبية/ العربية (العربنة).
( خامساً) المركزية السياسية والإدارية:
نشأت الدولة من مركز (الخرطوم)، وبيروقراطية مدنية مركزية موروثة من البريطانيين. وسيلتها مركزة السلطات بقبضها في العاصمة (الخرطوم)، وإهمال الأقاليم (المحافظات والمراكز). ما أنتج اختلالات لاحقة في التوازن السياسي والاجتماعي.
فالهوية السياسية الموروثة، أفرزت واقع المركزية السياسية والإدارية القابضة، بأن ورث السودان نموذجاً إدارياُ مفرط المركزية، تمحورت فيه الدولة حول الخرطوم كمركز للسلطة والقرار، وتجاهل الأقاليم الأخرى سياسياً وتنموياً، وحُرمت الأقاليم من تمثيل فعلي في مراكز القرار. فقد كانت المركزية الاستعمارية، أداة لضبط السلطة، وتسهيل إدارتها من المركز، لكنها بعد الاستقلال، أصبحت عاملًا بنيوياً في إنتاج التهميش واللاعدالة، وأدت إلى تفاوتات اقتصادية واجتماعية صارخة بين المركز والأطراف، وتغذية النزاعات المسلحة والتمرد في الجنوب(السودان القديم) وغرب وشرق السودان الحالي.
(سادساً) تشكل النخبة السياسية الحديثة:
نشأت نخبة مدنية تعليمية (الخريجون) على النمط البريطاني، وتبنت فكر التدرج والإصلاح، لا فكرة الثورة. ولذلك جاءت المؤسسات السياسية (المجلس الاستشاري، الجمعية التشريعية)، مزيج بين الرؤية الإدارية البريطانية والمطالب الوطنية. حيث ظهرت في ظل الحكم الثنائي نخبة مدنية حديثة، تأسست من:
(1) خريجي المدارس والمؤسسات التعليمية التي أنشأها الاستعمار على النمط البريطاني.
(2) أفراد ينتمون غالبًا إلى الوسط النيلي، ممّن حازوا فرصًا تعليمية وارتقوا في الوظيفة العامة.
وامتازت هذه النخبة بتبنّي فكر إصلاحي تدريجي، لا ثوري راديكالي. والتفاوض مع المستعمر بدلاً من مواجهته المباشرة. والجمع بين الوعي الوطني والرؤية الإدارية التي تشبّعوا بها خلال التعليم والعمل في الخدمة المدنية. وبذلك، صُممت المؤسسات السياسية الأولى(مثل المجلس الاستشاري، والجمعية التشريعية)، لتكون تركيبة هجينة، تجمع بين الشكل البريطاني (الإداري التمثيلي) وبين مطالب الحركة الوطنية. ولتكون المؤسسات السياسية أداة لامتصاص الاحتقان الوطني، أكثر من كونها تعبيراً عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
وعموماً، الدولة السودانية الحديثة، لم تنشأ نتيجة تطور طبيعي من داخل البنية الاجتماعية المحلية. بل جاءت كمحصلة، لتقاطع الإرث الاستعماري الإمبريالي، مع نخب حديثة، تعلّمت ضمن منظومة المستعمر، داخل إطار جغرافي وسياسي فُرض من الخارج. وهو ما أنتج دولة مفرطة المركزية، ومأزومة الهُوية، ومبنية على نخبة ضيقة التمثيل، تفتقر لشرعية داخلية متجذّرة. وعلى أساسها تشكلت صيرورة وسيروة بنى المؤسسات السياسية لدولة السودان الحالي. وللحديث بقية.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
05 أغسطس 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات