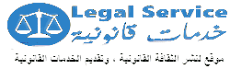مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان (5/ 1)
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
(Eltayeb2hussein@gmail.com - Eltayeb.hussein@yahoo.com
لا يُعدّ الدستور مجرد وثيقة قانونية إجرائية، بل هو تعبير عن رؤية فلسفية وتوجهات فكرية كبرى تحكم تصوّر الدولة لنفسها ولمجتمعها. فالدستور يُجسد تصوّرات عميقة حول طبيعة الدولة، ومصدر شرعيتها، وشكل العلاقة بين السلطة والمجتمع، ودور القانون ومؤسستي القضاء الدستوري والقضاء العادي في تنظيم هذه العلاقة. وتبعاً للتصورات المفاهيمية، التساؤلات التي تطرح نفسها، هل يكون القانون أداة لضبط السلطة ومساءلتها عبر قضاء مستقل ومتعدد المستويات، أم توظيف القانون ليكون وسيلة لتبرير سلطة الحاكم وتعزيز نفوذه؟ وهل الدستور يعكس مفهوم السيادة؟ أهي سيادة شعب تُبنى على الإرادة العامة والمشاركة الديمقراطية؟ أم سيادة حزب أو ملك تُستمد من عقيدة أيديولوجية أو تاريخ سلطوي؟ وهل القضاء الدستوري والقضاء العادي سلطتان مستقلتان تؤديان دوراً محورياً في تحقيق التوازن وضمان الرقابة على السلطة، أم مجرد أدوات قانونية ضمن بنية النظام الحاكم، تُستخدم لإضفاء شرعية شكلية على ممارساته؟ ففي ضوء هذه الرؤية، يتحدد مدى واقعية الفصل بين السلطات، ويتحدد مكانة القضاء الدستوري والقضاء العادي. وللمزيد راجع في ذلك: فريق شرطة (حقوقي)دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، التشريع وصناعة القانون (المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، المؤسسة العربية المتحده للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى، 2025م.
وللتوضيح، نتناول بإيجاز الفلسفة والتوجهات الفكرية التي تُشكّل الأساس البنيوي لكل من الدستور والمحكمة الدستورية، ونمط إدارة القضاء والعدالة. بإستعراض كيف تعبّر الخيارات التنظيمية والقانونية - في كل دولة - عن رؤية أعمق لطبيعة السلطة، وحدودها، وآليات الرقابة عليها، والدور المنوط بالقضاء في حماية النظام الدستوري وتوازن مؤسسات الدولة، بتناول وتقديم إشارة تحليلية مركزة على أبرز ملامح تلك التجارب.
(أولاً) دولة جمهورية فرنسا:
دولة جمهورية فرنسا، تمثل نموذج الديمقراطية الدستورية وفلسفة تقييد السلطة. والخلفية السياسية والفكرية العامة في بنية إدارة القضاء والعدالة، فرنسا من الدول التي لعبت دوراً مركزياً في تطوير الفكر الدستوري الحديث خصوصًا منذ الثورة الفرنسية 1789م. والفلسفة والتوجهات الفكرية السياسية الفرنسية، تقوم على مبادئ العقد الاجتماعي، وسيادة الشعب، وعلوية القانون، والفصل بين السلطات، متأثرة بفلاسفة التنوير الأوروبي مثل جان جاك روسو ومونتسكيو. ويُفهم الدستور في فرنسا، بأنه أداة لضبط السلطة (سلطات الحكومة) لا تجسيدها، إنما تقييدها. وضمان الحقوق، لا تقنين هيمنة الحاكم. وفي فرنسا توجد بنية مستقلة للمحكمة الدستورية، ممثلة في المجلس الدستوري، وهو هيئة مستقلة قائمة بذاتها، مهيكل خارج السلطة القضائية التقليدية، وأُنشئ في دستور 1958م للجمهورية الخامسة.
ويتكوّن المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ في البرلمان. والمجلس الدستوري ليس مجلس قضائي صرف، لكنه هيئة رقابة دستورية عليا،
يختص بالنظر في دستورية القوانين بعد إصداره ونشره الـ Promulgation بتوقيع رئيس الجمهورية على القانون بعد مناقشته والتصويت عليه في البرلمان. ونظام آلية الطعون الدستورية عند تطبيق القوانين فيما يعرف علية الـ QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité)، بمعنى السؤال الأولي عند مدى دستورية القانون، أي الرقابة الاحقة الشعبية التي يرفعها المواطنون ضد قانون أثناء محاكمتهم، إذا اعتبروا أن القانون الذي يُطبق عليهم ينتهك حقوقهم وحرياتهم الدستورية.
ونمط إدارة القضاء والعدالة في فرنسا، يتبنى النظام الثنائي الرأس للقضاء، بوجود القضاء العادي (قضاء المحاكم)، والقضاء الإداري (قضاء مجلس الدولة)، أي ثنائية النظام القضائي. ووجود المجلس الدستوري، وهو لا يتبع لأي من القضاء العادي أو القضاء الإداري، بل المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة. وهذا التوزيع في إدارة القضاء والعدالة في فرنسا، يعكس إيمان النظام الفرنسي بضرورة تعدّد آليات الضبط والمراجعة لتشريعات القوانين، واستقلال كل جهاز رقابي عن الآخر. وللقضاء في فرنسا دور فاعل في ضبط السلطة وحماية العقد الاجتماعي، حيث المجلس الدستوري يؤدي دوراً أساسياً في ضمان احترام مبدأ المشروعية الدستورية، وتقييد المشرّع بحدود الدستور، بقدر ما يحمي الحقوق والحريات الأساسية من تغوّل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. وهكذا، يظهر القضاء الدستوري كركيزة لحماية العقد الاجتماعي الذي يربط بين الحاكم والمحكوم. وعلى الرغم من أن تعيين أعضاء المجلس الدستوري يتم من السلطات السياسية، إلا أن فتراتهم محددة، وغير قابلة للتجديد، ويُمنع عزلهم، مما يعزز استقلاليتهم النسبية. كما أن توسّع اختصاصات المجلس الدستوري منذ 1971م جعله سلطة حقيقية في ضبط التوازن بين السلطات، وصيانة قيم المبادئ الجمهورية.
وبوجه عام، فرنسا تُجسد نموذجًا لدولة القانون في ظل نظام سياسي للحكم نصف رئاسي، وتفصل بين القضاء الدستوري - المتمثل في المجلس الدستوري – والقضاء بشقية القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة (القضاء الاداري). وفي النظام السياسي لإدارة وضبط السلطات، المجلس الدستوري هيئة مستقلة ذات وظيفة رقابية تشريعية، بينما القضاء العادي يُدار إدارياً من وزارة العدل. والنموذج الفرنسي يعكس رؤية فلسفية تمزج بين احترام الرقابة الدستورية على التشريع، وبين تنظيم مركزي للقضاء العادي، ضمن دولة إدارية قوية لا تفصل تماماً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على مستوى الإدارة القضائية.
( ثانياً): دولة مملكة المغرب:
دولة مملكة المغرب، نموذج للتدرج الدستوري والتأصيل المحلي للعدالة الدستورية. والخلفية السياسية والفكرية العامة للعدالة الدستورية في مملكة المغرب، أنها من الدول التي شهدت تدرجًا دستوريًا متواصلاً منذ أول دستور سنة 1962م. والنظام السياسي الدستوري في مملكة المغرب، ملكية دستورية تنفيذية، مع احتفاظ الملك بمكانة مركزية في النظام السياسي، تُوصف دستورياً بـأمير المؤمنين ورئيس الدولة. والفلسفة السياسية المغربية وتوجهاتها الفكرية تمزج بين المرجعية الإسلامية التقليدية، والخصوصية الثقافية الوطنية لدولة المغرب، والتأثر بالنموذجين الفرنسي والأوروبي. فقد تجلّى ذلك في التعديلات المتتالية للدستور التي بلغت ذروتها في دستور 2011م، والذي جاء استجابةً للحراك الشعبي في سياق ثورات الربيع العربي. وبنية المحكمة الدستورية في هياكل السلطة(الحكومة)، أنشأت المحكمة الدستورية رسميًا سنة 2011م خلفًا للمجلس الدستوري، وتتكون من 12 عضو، ستة أعضاء 50% يُعينهم الملك، والستة أعضاء الآخرين الـ 50% يُنتخبون بالتساوي من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويُشترط في الأعضاء الإثني عشر الكفاءة القانونية والخبرة. والمحكمة الدستورية في دولة مملكة المغرب مختصة بالرقابة الدستورية على القوانين قبل وبعد صدورها، وكما أن المحكمة الدستورية تفصل في نزاعات الانتخابات، وتراقب دستورية الأنظمة الداخلية للمؤسسات التشريعية. ونمط إدارة القضاء والعدالة، تتمتع المغرب بقضاء موحد، ويُدار من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه الملك. أما المحكمة الدستورية فتمثل رأسًا مستقلًا في منظومة القضاء، لا تخضع لوزير العدل، ولا تخضع للمجلس الأعلى للقضاء، ولا السلطة التشريعية. وهذا النموذج البنيوي للمحكمة الدستورية، يجمع بين عناصر الاستقلال والارتباط بالمؤسسة الملكية. ودور القضاء في ضبط السلطة وحماية العقد الاجتماعي، المحكمة الدستورية لها دور ملحوظً في حماية الحقوق والحريات العامة كما نص عليها دستور 2011م. وعملياً المحكمة الدستورية في المغرب، فرضت في عدة حالات رقابة دستورية حقيقية على النصوص القانونية لمخالفتها المبادئ الدستورية. وتوازن السلطات في المغرب، معتمد بدرجة كبيرة على الدور التوفيقي للمؤسسة الملكية أكثر من كونه حصيلة لصراع سلطات دستورية مستقلة تماما، تضع الملك متميزاً فوق سلطات الحكومة. وإستقلالية المحكمة الدستورية في المغرب، أنها تتمتع بهامش استقلال تنظيمي وقانوني معقول محدود، ولكنها تبقى جزء من منظومة دستورية ملكية، تضع الملك فوق السلطات الثلاث، وتمنح الملك صلاحيات واسعة، وهو ما ينعكس على فلسفة الرقابة وحدودها.
وبوجه عام، النموذج الدستوري في المغرب، يجمع بين عناصر من الإرث السلطاني الملكي الطابع الأسري والتقليد الفرنسي الأوروبي، مدمج هجيناً في سياق ملكية تنفيذية، تخضع فيها المحكمة الدستورية لموقع دستوري فوقي للملك، ما يجعل المحكمة الدستورية محكومة بضوابط سياسية دقيقة. ومع ذلك، فهي تمثل خطوة تطورية نحو تعزيز المشروعية القانونية والرقابة على السلطة. وبينما القضاء العادي، يُدار عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، ويضمن إشرافاً مباشراً على مرفق العدالة. والنموذج الدستوري المغربي، يعكس فلسفة وتوجهات فكرية دستورية، تسعى إلى تعزيز مؤسسات الدولة القانونية، دونما المساس بالمكانة المحورية للملك. باعتبار الملك هو المرجعية الدستورية العليا للعدالة، والضامن لوحدة الدولة واستقرارها.
(ثالثاً) دولة جمهورية الهند:
المحكمة العليا في الهند، تمثل نموذج للقضاء الدستوري المندمج. وبمقتضاه تمثل الهند نموذجاً فريدًا لدولة ديمقراطية ذات نظام جمهوري برلماني، يقوم على مبدأ سيادة الدستور، وفصل السلطات، واستقلال القضاء. وتُعد المحكمة العليا للهند (Supreme Court of India) أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي تمارس في الوقت نفسه وظائف القضاء العادي والقضاء الدستوري، ضمن نموذج القضاء الموحد Unified Judiciary، دون وجود محكمة دستورية منفصلة. وتنبع مكانة المحكمة العليا في الهند من فلسفة دستورية عميقة الجذور، تستند إلى الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، وسمو الدستور، حيث تُمثل المحكمة العليا صمام أمان لحماية الحقوق الأساسية، وتفسير الدستور، والفصل في النزاعات بين السلطات الاتحادية والولايات، والنظر في الطعون القضائية. وتمارس المحكمة العليا في الهند رقابة دستورية قوية، تشمل الرقابة القضائية على دستورية القوانين Judicial Review، وابتكار مبادئ قضائية محورية مثل: الهيكل الأساسي للدستور Basic Structure Doctrine، الذي يمنع البرلمان من تعديل الأسس الجوهرية للدستور، ولو عبر الإجراءات الدستورية المنصوص عليها.
وعلى صعيد إدارة القضاء والعدالة في الهند، تحتل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي، وتشرف على عمل المحاكم العليا في الولايات، وتعمل المحكمة العليا في ظل مجلس قضائي اتحادي غير مركزي في مظهره، لكن المحكمة العليا تحتفظ لنفسها بسلطة توجيهية وتأديبية واسعة. والقضاء الهندي مستقل نسبيًا عن السلطة التنفيذية، إذ يتم تعيين القضاة بناءً على توصيات الهيئة القضائية العليا Collegium. ومصطلح Collegium يستخدم في السياق القضائي الهندي، ويُشير إلى نظام تعيين القضاة في المحكمة العليا والمحاكم العليا في الولايات، ويُعد من السمات الفريدة للنظام القضائي الهندي، وله دلالات عميقة في الفلسفة الدستورية الهندية، خصوصًا في ما يتعلق باستقلال القضاء. ومعنى Collegium هو آلية غير منصوص عليها صراحة في الدستور، بل تم تطويرها من المحكمة العليا نفسها، من خلال سلسلة من الأحكام القضائية الشهيرة (ثلاثية قضايا القضاة Judges Cases، خصوصًا الحكم الصادر عام 1993م في القضية المعروفة بـ Second Judges Case . ويتكوّن Collegium من رئيس المحكمة العليا للهند، وأربعة من أقدم قضاة المحكمة العليا (من حيث الأقدمية)، ويُناط بهذا التشكيل مسؤولية اقتراح أسماء لتعيين قضاة المحكمة العليا، واقتراح تعيين قضاة محاكم الولايات العليا، وترقية أو نقل القضاة بين المحاكم. ودلالاته الفلسفية والدستورية، تعبير عن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. ونظام Collegium أتى رد فعل على محاولات سابقة من السلطة التنفيذية للهيمنة على تعيين القضاة، ويعتبر تجسيد عملي لمبدأ قضائي دستوري أرسته المحكمة العليا الهندية (القاضي لا يُعيّنه السياسي)، فهو مبدأ يضمن استقلال القضاء ويمنع تسييس القضاء والقضاة. ونظام Collegium تجسيد لسيادة القضاء على شؤونه الذاتية، وتعبير عن فلسفة وتوجهات فكرية ترى أن السلطة القضائية يجب أن تحكم وتدير نفسها بنفسها في ما يخص تعيين ونقل وترقي القضاة، دون تدخل من السلطة التشريعية أو التنفيذية. ورغم ما يوفّره نظام Collegium من حماية لاستقلال القضاء، إلا أنه يواجه انتقادات داخلية وخارجية تتعلق بانعدام الشفافية، وغياب المعايير الموضوعية الواضحة، لكونه مغلقًا على دائرة ضيقة من كبار القضاة (نُخبوية قضائية). ودلالة مصطلح NJAC، أنه يُجسّد صراع دستوري عميقًا في الهند يدور بين مسألتين؛ المسالة (الأولى) الرغبة في إصلاح آلية تعيين القضاة، وإخراجها من النخبوية القضائية المغلقة. والمسالة (الثانية) الحرص على إبقاء القضاء مستقل بالكامل عن تدخلات السياسة.
وواقع عملي لإيجابيات فاعلية نظام Collegiumفي السياق القضائي الهندي، رفض المحكمة العليا إنشاء أو تأسيس اللجنة الوطنية لتعيين القضاة NJAC National Judicial Appointments Commission من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وذلك عندما حاولت الحكومة في عام 2014م وعبر التعديل الدستوري رقم 99 لسنة 2014م، إنشاء هيئة مختلطة تعديلاً للدستور، بإدخال نظام NJAC لتعيين القضاة، وبنيوية النظام أنه هيئة مختلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، عضويتها من رئيس المحكمة العليا للهند، واثنان من أقدم القضاة في المحكمة العليا، ووزير العدل الاتحادي، واثنان من الشخصيات البارزة تعيّنهما لجنة مختلطة مكونة من رئيس الوزراء + زعيم المعارضة + رئيس المحكمة العليا. ليكون نظام NJAC بديل لنظام Collegium. فما كان من الحكمة العليا إلا أن قضت بأن التعديل الدستوري رقم 99 لسنة 2014َم غير دستوري، وأبطلت المحكمة العليا في حكم لها عام 2015م إنشاء اللجنة الوطنية لتعيين القضاة الـ NJAC، وأبطلت التعديل الدستوري، باعتبار التعديل الدستوري غير دستوري، واستندت المحكمة العليا في حكمها إلى مبدأ الهيكل الأساسي للدستور الـ Basic Structure Doctrine مسألة دستورية غير قابلة المساس بها، واعتبرت المحكمة العليا أن استقلال القضاء مسألة دستورية، وجزء متعلق بالهيكل الدستوري، ينبغي أن لا يُمسّ من الهيكل الدستوري، وعدّت المحكمة العليا التعديل الدستوري تهديد لفكرة الهيكل الأساسي للدستور بذاته في نفسه، لمساسه بالهيكل البنائي للدستور، ما يعزز حكم المحكمة العليا دلالة نظام الـ Collegium كجزء من الهيكل الاساسي البنائي للدستور. وفعالية نظام الـ Collegium أنه وجد إسناد جماهيري شعبوي عريض، لما حظي به من جدل كثيف في تعديل النظام الدستوري الهندي، لأن التعديل ارتبط بمحاولة السلطة التشريعية والتنفيذية إلغاء أو استبدال نظام الـ Collegium الذي تحتكره السلطة القضائية.
والدلالة الدستورية والسياسية لنظام الـ Collegium، أنه محاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من احتكار السلطة القضائية لتدابير الشئون الادارية للسلطة القضائية، بأن سعت إلى إستحداث نظام الـ NJAC National Judicial Appointments Commission لإخراج التعيينات القضائية من النطاق المغلق لنظام Collegium، وإدخال عناصر من السلطة التنفيذية والتشريعية، بدعوى تعزيز الشفافية والمساءلة. ولذلك اعتبر المعارضون – وأبرزهم قضاة المحكمة العليا نفسها - أن NJAC يشكل خطر على استقلال القضاء، وتهدّد لاستقلال القضاء، لأنها تُدخل أطرافاً سياسية (مثل وزير العدل) في شأن إداري يفترض أن يبقى الشأن الاداري شأن داخلي للقضاء في السلطة القضائية. وفي المحصلة النهائية، أصبح رفض الـ NJAC وترسيخ الـ Collegium، علامة بارزة على تمسّك النظام القضائي الهندي بفلسفة استقلال القضاء، كقيمة دستورية عليا، لا تخضع للأغلبية البرلمانية. وأن نظام الـ Collegium في الهند، ليس مجرد آلية إجرائية، بل هو تعبير عن رؤية دستورية عميقة، ترى في استقلال القضاء شرطًا أساسيًا للديمقراطية وحماية الحقوق. وأنه انعكاس لفلسفة وتوجهات فكرية، تجعل من القضاء حارسًا للدستور، لا تابعًا للسلطة السياسية. وأنه أنموذج لإدارة القضاء والعدالة، يعكس فلسفة ليبرالية دستورية، تؤمن بأن القضاء هو حارس الدستور والمدافع عن حقوق الأفراد، حتى في مواجهة الأغلبية البرلمانية. ومع ذلك، فإن التحديات المعاصرة - كالبطء في التقاضي، وتراكم القضايا، وتدخلات سياسية غير مباشرة - تضع ضغوطًا على نزاهة واستقلال المؤسسة القضائية في الهند.
وللحديث بقية، نستكمل فيها استعراض الجوانب الفلسفية والتوجهات الفكرية التي تشكّل الأساس البنيوي الدستوري لإدارة القضاء والعدالة في عدد من النظم الدستورية والقانونية، وإنعكاس هذه الفلسفات في بنية المحكمة الدستورية والقضاء، ونمط العلاقة بين السلطات، وطبيعة العلاقة بين القضاء وحكومات الدولة، ومدى انعكاس ذلك على مبدأ استقلال القضاء وحماية الحقوق، وتأثيراته على التوازن بين السلطات في إطار دولة القانون.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
01 أغسطس 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات