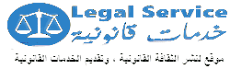مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان (3)
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
(Eltayeb2hussein@gmail.com - Eltayeb.hussein@yahoo.com
تنزيلاً على ما جاء في مقالات مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان(1، 2)، العديد من المداخلات والتعليقات الواردة في وسائط التواصل الاجتماعي وحسابات الفيسبوك وردت بالتعقيب، ومستخلصها يمكن أن نوجزه في الآتي:
1. القضية الجوهرية ليست أين توضع المحكمة الدستورية؟ بل كيف نبني بيئة دستورية وسياسية تحترم مبدأ الفصل بين السلطات. فمن دون ذلك(أي إحترام مبدأ الفصل بين السلطات)، ستظل كل المؤسسات القضائية والعدلية عرضة للتسييس وفقدان المصداقية، وسيبقى صرح القضاء والعدالة في السودان هشًّا وغير قادر على حماية الدستور أو المواطن.
2. حال القضاء والمؤسسات العدلية في السودان منذ بدايات الحكم الوطني الديمقراطي والحكم الشمولي، يسيطر عليها السلطة التنفيذية (الحكومة الإجرائية)، ويفتقر مقومات المعايير الدولية المتعارف عليها لإدارة القضاء والعدالة. وترتيباً على ذلك، مهما بلغت النصوص التشريعية الآمره بإستقلالية صرح القضاء والعدالة قوة بالنص عليها في الدستور والقانون، سيظل النص التشريعي شكلي ومجرد حبر على ورق.
3. إشكالية صرح القضاء والعدالة في السودان، ليست محصوره في إستقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة القضائية، إنما تشوهات واختلالات الوضع الدستوري في السودان وممارسة السلطة، واقع وسلوك لا يحترمان مبدأ الفصل بين السلطات. ولذلك، لا يمكن أن تكون المحكمة الدستورية وصرح القضاء والعدالة مستقله وفاعلة في بيئة تفتقر مبدا الفصل بين السلطات.
من مستخلص الردود والتعليقات والتعقيبات التي وردت متناولة مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان، يمكن القول أن المسألة الجوهرية التي يمكن طرحها وتحويلها إلى نقاش وحوارات، لا يقتصر على استقلالية المحكمة الدستورية فحسب، بل إنما يشمل البنية الدستورية والسياسية التي تعيق قيام صرح القضاء والعدالة في السودان. وتلك هي القضية الأساسية، ويمكن إيجاز نتيجة النقاش والحوارات في الآتي:
1. غياب بيئة مؤسسية تحترم الفصل بين السلطات:
الدستور السوداني والممارسة العملية، أظهرا خللًا بنيويًا؛ فحتى في وجود نصوص تكرّس الفصل بين السلطات، فإن الممارسة السياسية والسلطوية أدت إلى تداخل أدوار السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وترتيباً عليه، النتيجة المستخلصة، المحكمة الدستورية لا يمكن أن تمارس دورها الرقابي بحياد، لأن السلطة التنفيذية غالبًا ما تتحكم في تعيين القضاة وتمويل المؤسسات القضائية، مما يحول دون استقلالها.
2. تبعية المحكمة الدستورية للسلطة القضائية أو إستقلاليتها ليست المشكلة الوحيدة:
يظهر في سياقات الفعل والعمل السياسي السوداني، ضعف الثقافة السياسية الداعمة لسيادة القانون، مما أدى إلى تعثر تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وزيادة فرص التدخلات السياسية في عمل المؤسسات القضائية والدستورية في السودان، بإحدى أي من الوسائل الآتية:
(1) التوجيه والتأثير المباشر والضمني الغير مباشر على أعمال القضاء والمؤسسات العدلية، أو؛
(2) عدم إحترام مؤسسات الدولة في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، للتدابير القضائية الصادرة من محاكم السلطة القضائية، بعدم الإنصياع لأحكام القضاء أو رفض تنفيذ أحكام القضاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر الواقع العملي في السودان، أفرز بعض من الحالات، ونوجزها في الآتي:
(أ) دعوى الطعن الدستوري لحلّ الحزب الشيوعي وإسقاط عضوية إثنين من أبرز قادة الحزب الشيوعي في الجمعية التأسيسية لفترة الحكم الديمقراطي الأول، ورفض السلطة التشريعية تنفيذ حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، بإلغاء قرار حل الحزب الشيوعي، وإلغاء قرار إسقاط عضوية ممثلي الحزب الشيوعي في الجمعية التأسيسيه.
(ب) دعوى طعن دستوري بشأن قطعة أرض عليها مستشفى، الطاعن دستورياً فيها مستثمر سوداني طبيب من أبناء كسلا، والمطعون ضده دستورياً والي ولاية كسلا. وصدر فيها حكم دستوري لصالح الطاعن دستورياً، إلا أن المطعون ضده دستورياً والي ولاية كسلا، رفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية للعهدة الثانية. وصدرت فيها تدابير قضائية بفتح محضر تنفيذ باشره رئيس المحكمة الدستورية وقتها المرحوم مولانا / عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية للعهدة الثالثة) لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبمقتضاها إنصاع والي الولاية لتنفيذ الحكم.
(ب) قضية لضباط شرطة طاعنين في قرارات إدارية بإنهاء خدمتهم في الشرطة، رئيس مجلس السيادة (مطعون ضده أول) ووزير الداخلية (مطعون ضده ثاني). والطاعنين في الدعوى الإدارية نالوا حكم قضائي إنتهائي وبات، إلا أن وزير الداخلية (المطعون ضده الثاني) رفض تنفيذ الأحكام القضائية للدائرة الإدارية في المحكمة العليا الصادرة لصالح الطاعنين، والرفض بحجة إستحالة تنفيذ حكم محاكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا. والجدير بالذكر، رئيس مجلس السيادة (المطعون ضده الأول) أصدر توجيه بخطاب مكتوب لوزير الداخلية (المطعون ضده الثاني) يأمره بتنفيذ الحكم القضائي.
وخطورة رفض تنفيذ أحكام محاكم الدائرة الإدارية، هو أن الطاعنين المدعين في التنفيذ للحكم، تحصلوا على حكم تنفيذ قضائي بسريان غرامة مالية 30.000 جنيه عن كل يوم تأخير، تبداً من تاريخ إستقرار الأحكام القضائية، وأن سدادها من جيب ومال وزير الداخلية (المطعون ضده الثاني). وبالتالي، الغرامة المالية سارية لصالح ضباط الشرطة فرداً فرداً بصفة انهم المحكوم لهم وطالبي تنفيذ الحكم القضائي البات، وتلك الغرامة الماليه الساريه يتحملها وزراء الداخلية المتعاقبين على وزارة الداخلية من مالهم الخاص، وليست من خزينة الحكومة(الخزينة العامه).
وللتوضيح التشريعي لعقوبة فرض الغرامة المالية في حالات عدم تنفيذ رأس جهة الإدارة لأحكام المحكمة الإدارية المنصوص عليه في قانون القضاء الإداري 2005م تعديل 2017م، وبما في ذلك تحريك إجراءات جنائية ضد المسئول الإداري الأول لجهة الإدارة، أنها مادة مستحدثة في التعديل 2017م. والمادة المستحدثة من القانون نتاج ثمرة برلمان (تحت الشجرة مع ستات الشاي) بتناول كوب قهوة أو شاي من بعد رهق جلسات معلنة، بالجلوس تحت رواكيب ستات الشاي حول مباني المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف الخرطوم (أي مجتمع المحاكم/ لا مجمع المحاكم)، للإختلاف المصطلحي بينهما، وللمزيد راجع وأنظر في ذلك: فريق شرطة دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، التشريع وصناعة القانون (المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، الناشر: المؤسسة العربية المتحده للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى، 2025م). فقد كان التعديل لقانون القضاء الإداري 2005م بفرض تدابير عقابية من نقاش ثنائي مستفيض مع الأخ العميد شرطة (حقوقي) عبدالوهاب مكي أحمد (المحامي إستشاري القانون والموثق) خريج كلية الشرطة المصرية والمنتسب للدفعة 55 كلية الشرطة السودانية (بري). ففي النقاش المستفيض حول جوانب القصور التشريعي في قانون القضاء الإداري السوداني 2005م، أشار وأفصح الأخ العميد عبدالوهاب مكي (المحامي) لقانون القضاء الإداري المصري الذي يفرض تدابير عقابية في حالة رفض أو عدم تنفيذ أحكام محكمة الطعون الإدارية، بتوقيع جزاءات الغرامة المالية والسجن والفصل من الوظيفة للمسئول الأول على رأس جهة الإدارة وزارة أو مؤسسة في الحكومة. فكان التعديل في القانون 2005م بمقترح المادة بإقتباسها بما يتناسب من قانون القضاء الإداري المصري بتقديمه لقاضي الإستئناف المختص بالطعون الإدارية (الخرطوم)، والذي كان أحد أعضاء لجنة التعديل للقانون.
والنتيجة والدرس المستفاد من ظاهرة رفض أو عدم الإنصياع لأحكام المحاكم في السودان، أنه بسبب حالة الضعف بل الإنعدام والجهل بالثقافة السياسية الداعمة لسيادة القانون وسط الفاعلين في الحكومة. مما ترتب على ضعف الثقافة السياسية حالات إشكالية هشاشة الوضع الدستوري في السودان، وغياب العقل السياسي الوطني الواعي وسط النخب والصفوة الفاعلين في البيئة السياسية (الحكومة). فالسودان ظل وما زال يعاني من قصور فكري ونظري في مفهوم ودلالات الثقافة السياسية المؤسسية.
ومؤداه، النتيجة والخلاصة، لم تترسخ بعد القيم والسلوكيات الداعمة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار النظام الدستوري وفاعلية مؤسسات الدولة. وتبعاً لإفتقار عقل الثقافة السياسية في السودان، بلا شك، لا يصلح سؤال، هل تكون المحكمة الدستورية تابعة للسلطة القضائية أم مستقلة عنها؟ ولذلك، يصبح سؤال وضع المحكمة الدستورية في السودان، سؤال بلا معنى ولا جدوي ولا فائدة مرجوه، إذا كانت البيئة السياسية نفسها على رأس السلطة التنفيذية، تتغافل أو تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية. فالأولوية، إعادة بناء منظومة دستورية متوازنة للفصل بين السلطات، تضمن الآتي:
(1) الاستقلال المالي والإداري للقضاء، و؛
(2) وضع وإيجاد آليات شفافة لاختيار القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية، و؛
(3) إبعاد النفوذ السياسي عن القرارات القضائية، و؛
(4) تشريع قانون خاص، يمنع ويحظر التأثير والتدخل في أي من أعمال المحكمة الدستورية. وبما في ذلك، أعمال محاكم السلطة القضائية. وتوقيع عقوبات سالبة للحياة، أو سالبه للحرية بما لا يقل عن عام ميلادي، وتوقيع غرامات مالية. وعلى أن يشمل القانون الخاص النص على تدابير جزائية مالية وعقابية وإدارية، إذا رفضت أي من مؤسسات الحكومة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أو محاكم السلطة القضائية العادية.
3. انعكاسات التشوهات الدستورية على العدالة:
ويقصد بالتشوهات الدستورية على العدالة، الآثار السلبية الناجمة عن الخلل أو الضعف في النصوص التشريعية أو الممارسات الدستورية (القصور والفراغ التشريعي)، مثل: غياب الفصل الفعلي بين السلطات، أو تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية. فهي إختلالات تؤدي إلى إضعاف استقلال القضاء، وتقويض سيادة القانون، وتراجع وعدم ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
وانعكاسات التشوهات الدستورية على العدالة، يقصد بها الآثار البنيوية والوظيفية التي تنتج عن وجود خلل أو قصور في الإطار الدستوري، سواء على مستوى النصوص التشريعية أو الممارسة، بما يشمل غياب أو ضعف الفصل الفعلي بين السلطات، وتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وضعف الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء. وتمثلات انعكاسات التشوهات الدستورية على العدالة، نوجزها في الآتي:
(1) إضعاف قدرة النظام القضائي على أداء دوره في حماية الحقوق والحريات، و؛
(2) تراجع ثقة المجتمع بمؤسسات القضاء والعدالة، و؛
(3) ظهور العدالة الانتقائية، ومؤداه، تقويض سيادة القانون وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
والعدالة الانتقائية الـ Selective Justice مصطلح يستخدم في الدراسات القانونية والسياسية، لوصف حالة تطبيق القوانين أو مبدأ العدالة بطريقة غير متساوية أو متحيزة، بحيث يتم استهداف أفراد أو مجموعات معينة بالعقوبات أو المحاكمات، بينما يتم التغاضي عن آخرين ارتكبوا أفعالًا مماثلة أو أشد خطورة. وبمعنى آخر، العدالة الانتقائية هي الممارسة التمييزية في تطبيق القانون أو الإجراءات القضائية، بحيث تُستخدم أدوات العدالة (كالتحقيق، المحاكمة، أو العقوبة)، بطريقة غير محايدة لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية أو فئوية، مما يؤدي إلى تقويض مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء.
ومؤدى غياب ضمانات العدالة، النتائج الآتية:
(1) عدم ثقة المواطنين في القضاء.
(2) انتشار ظاهرة العدالة الانتقائية.
(3) ضعف وهروب الاستثمار الدولي الأجنبي، لغياب بيئة قانونية محايدة. أي تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الـ Foreign Direct Investment (FDI)، أو أن الاستثمار الأجنبي المباشر ينسحب بالكامل من دولة ما معينة بسبب غياب إطار قانوني وقضائي يتمتع بالحياد والشفافية، مما يجعل المستثمرين غير واثقين في حماية أموالهم وعقودهم من التدخلات السياسية أو تفشي حالات الفساد. وبمعنى آخر، انسحاب أو عزوف المستثمرين الدوليين عن دخول سوق دولة ما معينة، نتيجة انعدام أو ضعف الأطر القانونية والقضائية المستقلة، وغياب آليات إنفاذ العقود وحماية الملكية الفكرية والاقتصادية، مما يزيد المخاطر الاستثمارية في الدولة المعنية، ويخفض جاذبية السوق المحلي للإستثمار الدولي.
وبالتالي بالجملة، تصبح إعادة بناء صرح القضاء، مسألة تتجاوز الإصلاح المؤسسي، إلى إصلاح سياسي ودستوري شامل. أي بمعنى آخر، إعادة بناء صرح القضاء في الدول ذات الأزمات السياسية والأمنية الحرجه، ليست عملية فنية تقتصر على تطوير المحاكم أو تعيين الكفاءات وتحسين الوضع المعيشي للقضاة، بل هي عملية تحول هيكلي، تتطلب إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تضمن استقلال القضاء، وتوازن السلطات، وترسيخ سيادة القانون كإطار حاكم للنظام السياسي برمته. وللحديث بقية، أخذاً ومقارنة من نماذج وتجارب الدول عن مكانة وهيكلة وضعية المحكمة الدستورية من بنية الحكومات، وفحص التدابير التشريعية لضمانات إستقلالية المحكمة الدستورية والمحاكم العادية في بنية جهاز الحكومة لإدارة القضاء والعداله، ومرئيات معالجة وضع المحكمة الدستورية لإدارة القضاء بوحدة الرأس لا ثنائية الرأس.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
23 يوليو 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات