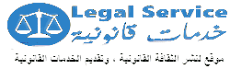مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان (10)
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
أثر التباين الفلسفي والفكري والمعرفي بين
عقل قاضي المحكمة الدستورية وعقل قاضي المحاكم العادية
-------------------------
يُعَدُّ موقع ومكانة المحكمة الدستورية في النظام القضائي السوداني، باعتبارها محكمة مستقلة تقع خارج بنية السلطة القضائية، من أكثر القضايا إثارة للجدل القانوني والسياسي. ما يعني إدارة القضاء والعدالة في السودان برأسين (ثنائية الرأس – Bisephalous Judiciary أو Dual-monistic Judiciary) في مقابل النموذج الأحادي (أحادية الرأس – Monocephalous Judiciary أو Judiciary Monistic). وإزاء ذلك، انقسمت آراء القضاة من القضاء الجالس والقضاء الواقف، إضافة إلى شريحة من الأكاديميين والفاعلين في الشأن العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بآراء متباينة حول الموقع الدستوري للمحكمة الدستورية، ولا سيما في ما يتعلق بحدود اختصاصاتها وسلطاتها. فقد أثارت المادة 11/(و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م (الملغي بقانون 2005م) جدلًا واسعًا، إذ منحت المحكمة الدستورية سلطة فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية. غير أنّ هذه المادة أُلغيت بموجب المادة 15/(2) من قانون المحكمة الدستورية 2005م، التي نصّت صراحة على أن أعمال السلطة القضائية، بما في ذلك أحكامها وقراراتها وإجراءاتها وأوامرها، لا تخضع لمراجعة المحكمة الدستورية، رغم أن المادة 15/(1) أكدت أن المحكمة الدستورية هي الحارس على الدستور ودساتير الولايات، وأن أحكامها نهائية وملزمة، وهو ما جعل النص ذاته مصدرًا لجدل جديد. فانقسمت الآراء إلى إتجاهين، الأول اتجاه رأى ضرورة تقليص سلطات المحكمة الدستورية، بحجة إفراطها في استخدام سلطتها في فحص أحكام وقرارات المحاكم، الأمر الذي أضعف مبدأ نهائية أحكام المحكمة العليا. والرأي الثاني تمسّك، بأهمية بسط رقابة المحكمة الدستورية على جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة، بما في ذلك السلطة القضائية، كلما تعارضت مع المبادئ الدستورية.
وهذا الجدل المثار في السودان، ليس محليًا فحسب، بل يجد نظيرًا له في التجربتين الأمريكية والهندية، حيث مثّلت سلطة التفسير القضائي أداة مركزية في تطوير القضاء الدستوري وصياغة قواعده. ففي الولايات المتحدة الامريكية، استندت المحكمة العليا إلى مرونة نصوص دستور موجز وإلى تقاليد الفيدرالية العريقة كقيم عليا، ما مكّن المحكمة العليا الأمريكية من لعب آداء دور ممارسة التشريع بتطوير نظرية المحكمة العليا الصانعة للقانون -Judge-Made Law / Court Making Law، خاصة في القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والحريات الفردية وحقوق الأقليات. وقد أنتج هذا الدور أثراً سياسياً واجتماعياً عميقاً، إذ تحولت الأحكام القضائية إلى أدوات إصلاحية، تجاوزت الجمود التشريعي الذي فرضته أحيانًا الحسابات السياسية داخل الكونغرس، الأمر الذي عرّض المحكمة العليا لانتقادات تتهمها بممارسة القضاء النشط Judicial Activism، ما دفع قوى سياسية إلى المطالبة بإعادة تعريف حدود سلطاتها.
أما المحكمة العليا الهندية، فقد اعتمدت على نصوص دستورية أكثر تفصيلًا، لكنها وسّعت نطاق سلطتها التقديرية من خلال تطوير نظرية البنية الأساسية للدستور الهندي Basic Structure Doctrine، بوصفها آلية وقائية ضد النزعات السلطوية التي قد تترتب على هيمنة الأغلبية البرلمانية. ما جعل المحكمة العليا الهندية ساحةً للصراع السياسي، يلجأ إليها الفاعلون السياسيون لحسم قضايا جوهرية، تمس سياسات الدولة واتجاهاتها المستقبلية. وبذلك أصبحت المحكمة العليا الهندية، لاعبًا محوريًا في صياغة المجال العام، وضبط العلاقة بين السلطات، وضمان استمرارية القيم الدستورية الأساسية. ليتضح أن الدور التشريعي للقضاء الدستوري عبر التفسير للنصوص التشريعية، لم يكن ممارسة قانونية تقنية فحسب، بل مثّل فعلًا سياسيًا بامتياز، أسهم في إعادة تشكيل البنية المؤسسية للنظام السياسي، وفي إعادة صياغة قواعد اللعبة الديمقراطية على نحو مستدام.
وعودة إلى المحكمة الدستورية في السودان، الذي يبدو من أحكامها فصلاً في الآراء المنقسمة، عن جدل استقلالية المحكمة الدستورية خارج بنية السلطة القضائية، وحول الخلفية التي أدت إلى إلغاء المادة 11(و) من قانون المحكمة 1998م. المحكمة الدستورية - في حكمها بالنمرة:م د /ق د/ 46/ 2005م شركة الصناعات الحديثة (سودان) /ضد/ بنك امدرمان الوطني، والمجلس الوطني، ورئيس الجمهورية، الصادر بتاريخ 8/8/2007م - أوضحت ضمن حييثيات أحكام لها، أن المحكمة الدستورية توسعت في تفسير المادة 11/(و) من القانون 1998م، بأن قامت بفحص أحكام وقرارات السلطة القضائية من الناحية الموضوعية، كما لو كانت المحكمة الدستورية جهة استئنافية لاحكام محاكم السلطة القضائية، مع أن نص المادة 11(و) من قانون 1998م، قاطع في أن سلطة الفحص هي للتأكد من سلامة أحكام واوامر السلطة القضائية من الناحية الدستورية، وأن كل خطأ في تطبيق القانون، ينشيء حقاً دستورياً بالطعن في أحكام السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية. وكما أشارت إلى أن التوسع في التفسير، أمر لا تحتمله المادة 11(و) من ذات القانون 1998م، الأمر الذي دفع المشرع لإلغاء المادة 11/(و) من قانون 1988م، التي فسرتها المحكمة الدستورية، بما يجعل من المحكمة الدستورية، درجة من درجات التقاضي فوق المحكمة العليا في السلطة القضائية. وأن إلغاء المشرع للمادة 11/(و) من قانون 1998م، اجراء عادي، وأسلوب مقبول ومعقول، ومعمول به، كلما رأى المشرع أن التفسير الذي جرى عليه العمل في موضوع معين، أصبح وصار لا يتفق مع الغرض الذي قصـده المشرع، أو أن الزمن قد تجاوزه.
وفي ذات السياق، للحد من جدل مرئيات وصف المحكمة الدستورية بـالقضاء النشِط Judicial Activism بحسب التجربتين الأمريكية والهندية، نشير لحكم المحكمة الدستورية الوارد في سياق المقالة هذه المشار إليه بالنمرة:م د /ق د/ 46/ 2005م (قضية شركة الصناعات الحديثة (سودان) /ضد/ بنك امدرمان الوطني، والمجلس الوطني، ورئيس الجمهورية)، فقد أشارت المحكمة الدستورية ضمن حيثييات الحكم إلى حكمها الشهير بالنمرة:م د/ق د/ 11/ 2006م مبارك ختمي حامد/ ضد/ الهيئة التشريعية القومية بتاريخ 25/06 / 2006م مضموم الدعوى الدستورية بالنمرة:م د/ق د/ع د/مراجعة /02 / 2006م بتاريخ 25/ 06/ 2006م مبارك ختمي /ضد/ ورثة محي الدين سوركتي وحكومة السودان. والذي يبدو من الحكمين الدستوريين، المحكمة الدستورية تبنّت موقفًا توفيقياً بين تيارات الآراء المنقسمة والمتباينة عن إستقلالية المحكمة الدستورية وعن سلطتها المقررة في المادة 11/(و) قانون 1998م الملغية بالمادة 15/(2) من قانون المحكمة الدستورية 2005م، حيث أكدت المحكمة الدستورية في حكمها أن العلاقة بينها(أي المحكمة الدستورية) وبين محاكم السلطة القضائية، ليست علاقة هرمية، بل إنما علاقة رقابية دستورية، بحيث تتدخل المحكمة الدستورية فقط متى إنطوت الأحكام القضائية على انتهاك دستوري.
ومن جهة ثانية من حيث العقل التفسيري للنصوص التشريعية، واقع عملي تطبيقي نجده في حكم صادر من محكمة إستئناف الخرطوم بالنمرة:م إس/723/ مستعجل /2022م بتاريخ 15 /08 /2022م، وحكم آخر ذات صلة صادر من المحكمة العليا بالنمرة:م ع/ط م/1403م/2022م بتاريخ 17 /12 /2022م، قضي بإلغاء حكم محكمة استئناف الخرطوم، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى. ومثار الحكمين، محكمة الموضوع الابتدائية دائرة الخرطوم شمال في دعوى عقارية بإدعاء أنها محمولة برهن تمويلي من بنك، شطبت دفوع المدعي في القضية المدنية بالنمرة: ق.م.3035 /2021م، وصاغت نقاط النزاع للفصل الموضوعي في الدعوى العقارية، لأيلولة العقار بالشراء للمدعي في مزاد علني وفقاً لقانون الأموال المرهونة للمصارف 1998م. وواقعاً من حيث الموضوع تم غلق الرهن التمويلي لدى البنك المعني، ودخول ذات البنك مع المدعى عليها في عمليات تمويل جديد بسبعة عقود بصيغة عقد المضاربة مقابل تحرير شيكات مشروطة من البنك بقيمة كل عقد، إستلم البنك كامل مبلغ التمويل بشيكات سبعة مؤجلة الدفع والسداد. إلا أن المدعي أمام محكمة استئناف الخرطوم، تقدم بإستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، وصدر حكم الاستئناف بقبول استئناف المدعي وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى. والذي صار تواصلت سلسلة الطعون القضائية من المدعى عليها أمام محكمة النقض ودائرة المراجعة والفحص في بنية المحكمة العليا، وإنتهت بشطب طعون المدعى عليها بالنقض والمراجعة والفحص داخل المحكمة العليا، وعلى أثرها المدعى عليها تقدمت بعريضة دعوى طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية، وإستصدار أمر إيقاف بعريضة الطعن الدستوري. وتبعاً لإجراءات التقاضي، خلال مسيرة الدعوى، صدر حكم إبتدائي إستعجالي من محكمة الموضوع لصالح المدعي، بإصدار حكم أولي Preliminary يقضي بإخلاء العقار، ومن ثم، الاستمرار في الدعوى للفصل الموضوعي في طلب التعويض.
إلا أن المدعى عليها، تقدمت بطعن إستئنافي أمام محكمة الاستئناف، بحجج وأسانيد وجود دعاوى قضائية أخرى قيد النظر بذات موضوع الدعوى الابتدائية والطعن الاستئنافي وأطرافها. الدعوى الأولى، بذات أطراف الدعوى الابتدائية والاستئناف، أمام ذات محكمة الخرطوم شمال التجارية في دعوى إبطال بيع ذات العقار موضوع الدعوى المدنية، وما زالت قيد النظر من محكمة الموضوع. والدعوى الثانية، طلب من المدعى عليها متعلق بذات دعوى المدعي، لفحص تدابير قضائية لحكم مراجعة صادر من المحكمة العليا دائرة المراجعة قيودات بالنمرة 55/2021م بتاريخ 24 /10 /2021م في الطعن بالنقض المقدم من المدعى عليها بالنمرة:م ع/ط م/1584/ 2019م بتاريخ 06 /08 /2020م ضد حكم إستئناف الخرطوم قيودات بالنمرة:م إس/ 723/ مستعجل /2022م بتاريخ 15 /08 /2022م، وطلب الفحص من المدعى عليها بدفع موضوع وقانون، بما يفيد أن محكمتي النقض ودائرة المراجعة في المحكمة العليا، محكمة غير مختصة. ودعوى قضائية ثالثة، ضد تدابير محكمة الاستئناف، المؤيد من المحكمة العليا، لايداع المدعى عليها أمام المحكمة الدستورية عريضة دعوى طعن دستوري بالنمرة:م د/ع د/23 /2022م بتاريخ 20 /02 /2022م، وبما في ذلك ايداع طلب وقف تنفيذ بعريضة لاستصدار أمر إيقاف من المحكمة الدستورية وسددت الرسوم القضائية عليهما. وبمقتضاه، المدعى عليها تقدمت بدفع موضوع ودفع دستوري، بناء على المبادئ الدستورية المقررة من المحكمة الدستورية في حكميها في الطعنين الدستوريين بالنمرة:م د /ق د/ 46/ 2005م شركة الصناعات الحديثة (سودان) /ضد/ بنك امدرمان الوطني، والمجلس الوطني، ورئيس الجمهورية، وبما ذلك، حكم المحكمة الدستورية بالنمرة:م د/ق د/ 11/ 2006م مبارك ختمي حامد/ ضد/ الهيئة التشريعية القومية مضموم مع الدعوى الدستورية بالنمرة:م د/ق د / ع د/مراجعة /02 / 2006م مبارك ختمي / ضد/ ورثة محي الدين سوركتي وحكومة السودان. بحجج وأسانيد تقدمت بها المدعى عليها، بوجود دعوى قضائية دستورية بذات موضوع الاستئناف من المدعي.
وخاتمة المطاف، محكمة الاستئناف الخرطوم، شطبت قرار محكمة الموضوع في الدعوى 3035/2021م العقارية. ومقررة محكمة الاستئناف فصلاً في دفوعات المدعى عليها، تفسيراً لسابقتي حكم المحكمة الدستورية (مبارك ختمي)، أن دائرة الفحص في المحكمة العليا رفضت طلب الفحص المقدم من المدعى عليها. وبالتالي، لا يوجد رابط عضوي بينها(أي محكمة الاسئناف) وبين المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية، ليست درجة من درجات التقاضي، ليكون الدفع أمامها (أي أمام محكمة الاسئناف) بحجج وأسانيد أحكام وقرارات المحكمة الدستورية.
وتأسيساً عليه، رفضت محكمة الاستئناف الدفع المقدم من المدعى عليها، بوجود عريضة دعوى طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية ضد جملة التدابير القضائية الصادرة من المحكمة العليا، ورفضها(أي محكمة الاسئناف) لأمر الإيقاف الصادر من المحكمة الدستورية. ودونما إعتبار من محكمة الاستئناف للدفوعات الموضوعية للمدعى عليها فصلا فيها، بوجود دعوى مدنية بذات موضوع الاستئناف وأطرافه أمام محكمة الموضوع دائرة الخرطوم شمال التجارية. الأمر الذي إستدعى من المدعى عليها اللجوء لمحكمة النقض في المحكمة العليا، بدفوعات أن المحكمة الدستورية محكمة منشأة بقانون، والتقاضي امامها مكفول وفقاً للقانون، وأن التدابير الاجرائية والشكلية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية 2005م وقانون الاجراءات المدنية 1983م، يعطي حق للمدعى عليها باللجوء للمحكمة الدستورية، مما ينشئ دعوى قضائية قيد النظر للفصل فيها دستورياً. ومواصلة لمسيرة إجراءات الدعوى 3035 /2021م، المدعى عليها وعلى أساس الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، إنتهى الطعن بالنقض بحكم يقضي بإلغاء أحكام وتدابير محكمة الاستئناف والموضوع، والأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، لصياغة نقطة نزاع جديده. مستندة المحكمة العليا في حكمها على دفع قانون لمحامي المدعى عليها في الطعن بالفحص، أن الدعاوي العقارية لا يشملها صفة الأموال المحمولة بالدين للمدعي على عاتق المدعى عليه، ودفع لآخر من القانون لإصدار محكمة الموضوع حكم أولي Preliminary بإخلاء العقار، ومن ثم السير في إجراءات الدعوى للبت الموضوعي النهائي في الدعوى. ودونما أن تفصل أو ترد المحكمة العليا (دائرة النقض) بشأن دفوع أخرى، أثارها محامي المدعى عليها، بوجود دعاوي قضائية قيد النظر، ودونما الفصل أو الرد على تفسيرات محكمة الاستئناف الخرطوم، الرافض بالدفع أمامها بأحكام واوامر المحكمة الدستورية. وللمزيد راجع في ذلك، فريق شرطة (حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، كتاب: التشريع وصناعة القانون - المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – (رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة/ الجيزة/ فيصل شارع القناوي، الطبعة الأولى، 2025م.
وتبعا عليه، التباين في الفلسفات وتوجهات الفكر القانوني للمشتغلين في مهنة القانون والمهتمين، يثير تساؤلاً جوهريًا حول أثر التباين الفلسفي والفكري والمعرفي بين عقل القاضي الدستوري وعقل القاضي في المحاكم العادية بمستوياتها المختلفة، نظراً إليها من إستقرار الاحكام القضائية، وهدم وردم فجوة تداعيات عدم إستقرار الاحكام القضائية على منظومة العدالة، لما تؤدية من آثار ارتباك في بوصلة العدالة، خصوصاً إذا ما تداخلت الاختصاصات، أو إذا ما تعارضت الاحكام والقرارات والأوامر القضائية بين القضاء الدستوري والقضاء العادي. أو نشوء توترات مؤسسية بين قضاة ذات مناهج وأطر فكرية مختلفة، ما قد يؤثر على ثقة الجمهور بالقضاء ككل. وإحداث صعوبة في التنسيق بين فقه الدستور والفقه القضائي العادي، خصوصاً في الدول التي لا تزال في طور تطوير بنيتها الدستورية. وللتوضيح، نشير لبعض الملامح بحسبما يلي:
(أولاً) تعريف العقل القضائي:
--------------------------
العقل القضائي للقضاة(أي قاضي)، ليس مجرد تطبيق للنص التشريعي، بل هو بنية تأويلية، تتشكل من خلفيات فلسفية، معرفية، ومؤسسية. فبينما عقل قاضي المحكمة الدستورية، يُعيد إنتاج النص في ضوء المبادئ العليا، تبعاً للمبادئ الدستورية، سيادة الدستور، سمو القانون، مبدأ المساواة، مبدأ العدالة، والقيم الأساسية للمجتمع، الحرية، الكرامة الإنسانية، الفصل بين السلطات، والمعايير الدولية أحيانًا؛ حقوق الإنسان، العهد الدولي. وبينما في المقابل المقارن، عقل قاضي المحاكم العادية، يُعيد إنتاج الوقائع في ضوء النصوص التشريعية القانونية.
وبالنظر في الفروقات الفلسفية بين العقلين، عقل قاضي المحكمة الدستورية يتبنى فلسفة معيارية Normative، تُعلي من المبادئ العليا. وعقل قاضي المحاكم العادية، يتبنى فلسفة تطبيقيه Pragmatic، تُعلي من الإجراءات. ومن حيث الفروقات المعرفية بين العقلين، عقل قاضي المحكمة الدستورية، يُوظف أدوات متعددة لبلوغ الغاية والهدف، فهو يعتمد على الفقه المقارن، السوابق الدولية، النظرية الدستورية. وعقل قاضي المحاكم العادية، يعتمد على القانون الوطني، السوابق المحلية، والتفسير التقليدي.
وتبعاً له، العلاقة بين النص التشريعي من القانون والتأويل في العقلين. النص القانوني لا يُفسر بذاته، بل عبر عقل قضائي يُعيد إنتاجه. فبينما التأويل الدستوري للتشريع، يُعيد بناء النص القانوني في ضوء فلسفة النظام، فإن التأويل القانوني يُعيد تطبيقه في ضوء الوقائع. ولذلك قاضي المحكمة الدستورية، أحكامه ذات أثر عام erga omnes، وتؤثر في التشريع والسياسة والمجتمع. بينما القاضي العادي، أحكامه ذات أثر نسبي، تخص أطراف النزاع فقط. وبالنظر إلى أثر تباين العقلين على العملية القضائية والعدالة، التباين يخلق تفاوتًا في حجم التأثير؛ الأول يغير قواعد اللعبة السياسية والقانونية، والثاني يضمن استقرار العلاقات اليومية.
(ثانياً) قاضي محكمة الموضوع (الابتدائية)
-----------------------
من حيث العقل القضائي، فهو(أي قاضي محكمة الموضوع) عقل تحليلي واقعي، ينشغل بالوقائع والأدلة، وتطبيق النصوص القانونية بصورة عادلة ومباشرة. ومقارنة قاضي محكمة الموضوع مع قاضي المحكمة الدستورية، قاضي المحكمة الدستورية لا ينشغل عمليا بتفاصيل الواقعة(الوقائع)، إنما عملياً ينشغل بالمبادئ الكلية للوقائع، وصحة القاعدة القانونية ذاتها. ومن حيث أثر تباين العقلين، يظهر التباين، بين، عدالة واقعية جزئية، يسعى إليها قاضي محكمة الموضوع، وعدالة جزئية كلية، ينشدها قاضي المحكمة الدستورية.
(ثانيًا) قاضي محكمة الاستئناف:
------------------------
العقل القضائي لقاضي محكمة الاستئناف، عقل مراجعي نقدي(مراجعة نقدية/ إنتقادية)، يركز على تصحيح الأخطاء القانونية والواقعية في حكم محكمة الموضوع، ويسعى إلى توحيد التفسير داخل نطاق الاستئناف. ومقارنة مع قاضي المحكمة الدستورية، قاضي المحكمة الدستورية، ينظر إلى صحة النصوص التشريعية من القانون، ومدى مطابقتها للدستور. بينما قاضي محكمة الاستئناف، ينظر فقط إلى مدى صحة تطبيق تشريع القانون وإنزاله على الواقعة. ومن حيث أثر تباين العقلين على العملية القضائية والعدالة، يظهر التباين في أن قاضي المحكمة الدستورية، يتجاوز الحكم محل النزاع، ليؤثر في التشريع ذاته(أي محاكمة التشريع). بينما قاضي محكمة الاستئناف، يظل محصوراً في تصحيح الأخطاء من القانون(أي محاكمة حكم قاضي محكمة الموضوع).
(ثالثًا) قاضي محكمة النقض (المحكمة العليا):
----------------------
العقل القضائي لقاضي محكمة النقض في المحكمة العليا، عقل قانوني خالص، وحارس لوحدة القانون، وصحة تطبيقه، ويمارس وظيفة قضائية معيارية، لكنها داخل حدود القانون الوضعي. ومقارنة بقاضي المحكمة الدستورية، كلاهما يملك عقلاً قضائياً معياريًا. لكن معيارية قاضي محكمة النقض، محصورة في القانون العادي. بينما معيارية قاضي المحكمة الدستورية، تتعلق بالدستور ومحصورة فيه، بوصفه قمة الهرم القانوني والقضائي. ومن حيث أثر التباين في العقلين، يبرز التباين في حدود المعيارية. قاضي محكمة النقض، يحافظ على اتساق القانون. وقاضي المحكمة الدستورية، يحافظ على سمو الدستور.
(رابعاً) قاضي محكمة دائرة المراجعة:
--------------------
العقل القضائي لقاضي دائرة المراجعة، عقل استثنائي فوق النقض، يراجع الأحكام النهائية، لأسباب جوهرية - خطأ بيّن واضح، تعارض أحكام، مستجدات قانونية - اغفلتها محكمة دائرة النقض، أو أن قاضي محكمة النقض، لم يفصل في سبب جوهري، أثاره الطاعن بالنقض. ومقارنة بقاضي المحكمة الدستورية، كلاهما يعيد النظر في نهائية الاحكام. لكن قاضي المحكمة الدستورية يعيد النظر في نهائية الاحكام، لحماية القيم الدستورية والمبادئ العليا. بينما قاضي محكمة دائرة المراجعة، يعيد النظر في نهائية الاحكام، لحماية اليقين القانوني، وحماية العدالة الفردية. ومن حيث أثر تباين العقلين، يبدو أثر التباين في طبيعة الغاية. فقاضي المحكمة الدستورية، يراجع إنتهائية الاحكام في المحكمة العليا، لحماية المبادئ العليا والقيم الدستورية. بينما قاضي دائرة المراجعة، يراجع أحكام محكمة دائرة النقض، لحماية الأمن القانوني.
(خامساً) قاضي دائرة الفحص:
--------------------
في الانظمة التقليدية القانونية القضائية، العقل القضائي لقاضي محكمة دائرة الفحص في المحكمة العليا، عقل تصفية ومرشح للطعون لنظرها أمام المحكمة العليا Screening and filtering mechanism، أي دوره إجرائي أكثر منه موضوعي، فهو القاضي الذي يحدد فقط ما يستحق النظر فيه، ويمارس سلطة انتقائية لفحص طلبات الطعن أو المراجعة، قبل قبولها للفصل الموضوعي، ويُعد عقلًا استراتيجياً في هرمية القضاء العادي. ومقارنة بقاضي المحكمة الدستورية، أيضاً قاضي المحكمة الدستورية يمارس دور التصفية، عندما تحدد ما يُقبل من دعاوى دستورية أو لا يقبل (القبول الشكلي) من الدائرة الثلاثية في المحكمة الدستورية، ولكن معايير قبول الطعن الدستوري من حيث الموضوع سياسية – حقوقية. بينما معايير الفحص في المحاكم العادية في المحكمة العليا إجرائية - قانونية. ومن حيث أثر التباين، يظهر التباين بين تصفية إجرائية عند الفحص في المحكمة العليا، وتصفية دستورية، عند الفحص في المحكمة الدستورية.
وقاضي الفحص في بعض الأنظمة القانونية والقضائية التي تجعل دائرة الفحص فوق دائرة المراجعة وحالات مراجعة المراجعة لمرحلة ولحالات معينة. وهو ما قررته المحكمة العليا في السودان في حكم لها غير مسجل في قائمة سجل قضايا المحكمة العليا قيودات النمرة:م ع/ط م/ 2166 /2016م/ مراجعة / 474 /2017م صادرة بتاريخ 07 /07 /2018م جمال مرقص/ضد/ ورثة مكرم مرقص وآخر، والحكم بذات النمرة كطلب فحص بتاريخ 04 /11/ 2020م قيودات المحكمة القومية العليا. لإعتبار الواقع العملي بالسوابق القضائية قرر مبدأ قضائي مأخوذ قاعدة قانونية، أرست مبدأ فحص الأحكام ومراجعتها، وأرست مبدأ مراجعة المحكمة العليا لأحكام المراجعة الصادرة من دائرة المراجعة، وللمزيد أنظر، فريق شرطة(حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود(المحامي إستشاري القانون والموثق)، كتاب: التشريع وصناعة القانون - المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – (رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة/ الجيزة/ فيصل شارع القناوي، الطبعة الأولى، 2025م.
ونزولاً على ما تقرره أحكام المحكمة العليا، نجد أن دائرة الفحص في الهرم القضائي، تأتي بعد وفوق دائرة المراجعة، أي أنها محكمة أعلى درجة من محكمة دائرة المراجعة، ودورها ليست مجرد مرحلة إجرائية، إنما تصدر أحكام وأوامر وقرارات. وبالتالي، العقل القضائي لقاضي محكمة الفحص، يتحول من عقل تصفية إجرائية، إلى، عقل تصفية نهائية استراتيجية، حيث يقرر في قضايا حُسمت في النقض ثم المراجعة. بمعني الوظيفة القضائية لقاضي محكمة الفحص، أنه يسعى لضمان الأمن القضائي النهائي Final Judicial Security، بوضع نهاية مطلقة للتقاضي، ومعالجة أي خلل نتج حتى بعد المراجعة، حمايةً لوحدة العدالة.
ومن حيث اثر التباين مع قاضي المحكمة الدستورية، قاضي الفحص الفوق المراجعة، ينظر إلى العدالة من زاوية النظام القانوني الداخلي، ويركز على اليقين القضائي النهائي. أما قاضي المحكمة الدستورية، فهو ينظر إلى العدالة من زاوية المبادئ العليا والقيم الدستورية، ويركز على الشرعية الدستورية العليا، حتى لو أدى ذلك إلى هدم حكم نهائي أصدرته المحاكم العادية في المحكمة العليا. أي بمعنى آخر، قاضي الفحص يسعى إلى إغلاق باب النزاع نهائيًا باسم الأمن القضائي. بينما القاضي المحكمة الدستورية، يحتفظ بحق فتح الدعوى القضائية مجدداً، إذا تعارض الحكم القضائي لمحاكم القضاء العادي مع الدستور أو الحقوق الأساسية. وتبعاً له، البعد الفلسفي لقاضي الفحص، يتبنى فلسفة التصفية النهائية Finality Philosophy. بينما قاضي المحكمة الدستورية، يتبنى فلسفة السمو والشرعية Supremacy Philosophy. فعندما تُوضَع دائرة الفحص فوق دائرة المراجعة، تتحول دائرة الفحص إلى قمة هرم التقاضي العادي. بينما تبقى المحكمة الدستورية، قمة النظام القانوني الدستوري، أي المحكمة الدستورية أعلى من كل هذا الهرم، لأنها تراجع القواعد نفسها، وليس فقط الأحكام.
وقاضي محكمة الفحص كمحكمة عدالة في مستويات درجات الاستئناف والنقض والمرجعة، لا تتقيد بالآجال الزمنية، وينظر إليه من زاوية أن القاضي العادي ملتزم بالتقيد الحرفي بالآجال الزمنية، ففوات ميعاد الطعن، يعني سقوط الحق في الاستئناف أو النقض أو المراجعة. وهنا قاضي الفحص، يتقمص دور محكمة العدالة Equity Court، حيث يوازن بين: مبدأ الاستقرار القضائي Finality، ومبدأ العدالة الجوهرية Substantive Justice. فإذا رجح الثاني، جاز لقاضي الفحص قبول الطعن رغم فوات الميعاد. ومن حيث الأثر الفلسفي، فحص الاحكام يُدخل البعد الإنصافيEquitable في عمل قاضي الفحص، إلى جانب البعد القانوني. ويجعل عقل قاضي الفحص أقرب إلى عقل القاضي الدستوري، الذي يتجاوز القيود الشكلية لحماية الحقوق والحريات. ومن حيث التباين مع القاضي الدستوري، قاضي الفحص كمحكمة عدالة، يتجاوز القيود الزمنية الإجرائية في حدود النزاع الفردي، بغرض إنصاف المتقاضي. بينما قاضي المحكمة الدستورية، يتجاوز كل القيود الشكلية، إذا كان هناك انتهاك لمبدأ دستوري أو لحق أساسي، وأحكامه ذات أثر عام. ومن حيث الأثر، كلاهما يضع العدالة فوق الشكل، لكن: قاضي الفحص يقوم بوظيفته القضائية، لإنقاذ حق فردي. بينما قاضي المحكمة الدستورية، يقوم بوظيفته القضائية كقاضي محكمة دستورية، لحماية قيم ومبادئ عليا دستورية. وحيث في ذات السياق، بعض الرأي ينبه من نشوء مخاطر الفحص وحدوده في المحاكم العادية، لأنه إذا توسع قاضي الفحص في فحص الاحكام، قد يهزّ استقرار النظام الإجرائي، ويفتح الباب للتقاضي غير المنضبط. ولذلك غالبًا ما يُقيد سلطانه بضوابط صارمة، مثل: وجود عذر قاهر، أو سبب استثنائي موضوعي مقبول. فعندما يُنظر إلى قاضي الفحص كمحكمة عدالة، فإنه يتحول من مجرد حارس للأمن القضائي النهائي، إلى جسر إنصافي يسمح بتمرير العدالة، على الرغم من فوات المواعيد الشكلية. وبذلك قاضي الفحص يقف في منطقة وسطى، بين القاضي العادي الملتزم بالشكل، والقاضي الدستوري المتجاوز للشكل باسم سمو المبادئ الدستورية.
وللحديث بقية، نتناول فيه، أطر كيفية المعالجة والتوفيق، بين، عقل الفلسفة والفكر القانوني القضائي، لقاضي المحكمة الدستورية ولقاضي المحاكم العادية بمختلف مستوياتها. ومحاولة تناول معايير ضمانات المحاكمة العادلة، على، المستويين الدستوري والقانوني، والممارسات الدستورية والقضائية.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
23 أغسطس 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات