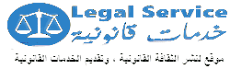قراءة أولية تحليلية عن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جمهورية السودان ضد الأمارات العربية المتحدة
لتحليل الحكم القضائي لمحكمة العدل الدولية(لاهاي) الصادر في شكوى جمهورية السودان ضد الأمارات العربية المتحدة، وإقتباساً إستعارة من نصوص القانون الدولي ومن حيثييات الحكم القضائي لمحكمة العدل الدولية، وبما يتناسب ويتفق من التسبيب التحييثي والإقتباس، نطرح فرضيات شوائب وقصور الحكم القضائي من الفرضيات الآتية:
1. قبول الدعوى دواعيه البت في التدابير الوقتية الطارئة المقدم من جمهورية السودان، ويحكمها مبادئ الإختصاص على الرغم من وجود التحفظات، لأن مبادئ الاختصاص، مستمدة أصلاً من قواعد الإختصاص المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحده 1945م والنظام الأساسي للمحكمة 1945م ولائحة المحكمة 1978م، وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م؛ وذلك لخطورة جريمة الإبادة الجماعية على البشرية والإنسانية، وللمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وتنمية وترقية التعاون الدولي بين الدول، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 1945م والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ بأن تتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية التعاهدية، بأن تتخذ الأمارات العربية المتحدة كافة التدابير اللازمة لمنع إرتكاب أفعال جريمة الإبادة الجماعية الواقعة على جماعة إثنية المساليت السودانيين في غرب ولاية دارفور؛ وأن تتقيد الأمارات العربية المتحدة ضمن تعهداتها الإتفاقية بكافة إلتزاماتها التعاقدية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 1945 وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، بأن تتخذ الأمارات العربية المتحدة من التدابير والإجراءات الكافية بما يمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية على قبيلة إثنية المساليت السودانية، وأن لا تدعم وأن لا تقوم بتقديم أي تسهيلات لمليشيا الدعم السريع الشبه عسكريه.
2. الإختصاص المنصوص عليه في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، هي نقطة نزاع أساسية وجوهرية في الدعوى من جمهورية السودان ضد الأمارات العربية المتحدة، مما يتطلب ذلك البت في مسألة الإختصاص من حيث الحالة الواقعية والقانونية، بأن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها؛ لتقديم ممثلي الأمارات العربية المتحدة ثلاثة مستندات على أنها صيغة التحفظ المنصوص عليه في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م؛ وحيث المستندات المقدمة للمحكمة على زعم أنها التحفظ المكتوب؛ وواحد منها مكتوب باللغة العربية، وإثنين باللغة الإنجليزية، وبينها خلط وتناقض في الترجمة اللغوية لصيغة التحفظ؛ ولطرح المحكمة سؤال مباشر على ممثلي الأمارات العربية المتحدة، لبيان سبب التحفظ على إختصاص محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م.
3. قواعد الإختصاص المنصوص عليها في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، من حيث الواقع والقانون، يتطلب فيها من المحكمة السماع الخاص بدراسة مذكرات مرافعات الأطراف لإستنتاج الجوانب القانونية المحيطة بالتحفظ وأسبابه، والسماع العام بتقديم وتحليل المستندات من الحالة الواقعية والقانون للمستندات، لتستخلص المحكمة من المستندات، أسباب التحفظ ودواعية، ولتتمكن المحكمة من الوقوف على مدى سلامة وصحة التحفظ المقرر وفق إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، والبت السليم في التحفظ من حالته الوقائعية والقانون.
4. طلب الإجراءات التحفظية تقتضيه دواعي الغرض من ميثاق الأمم المتحدة 1945م وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، لضرورة الحفاظ على نوع الجنس البشري، ولدواعي حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول، وحماية حقوق الإنسان.
5. الحكم القضائي الصادر من محكمة العدل الدولية، لم يبت بقرار من المحكمة في طلب الإنضمام والتدخل في الدعوى المقدم من دولة صربيا بتاريخ 24 أبريل 2025م، وحيث يمثل جمهورية صربيا البروفيسور ألكسندر غايتش (دكتوراه في القانون الدولي)، بصفته المستشار القانوني الأول في وزارة الخارجية الصربية، وبصفته وكيلاً للدولة؛ ورغماً عن ذلك بتاريخ 05/ 05/ 2025م، المحكمة أصدرت الحكم في الدعوى برفضها، والأمر بشطبها من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ وعلى الرغم من تحديد المحكمة لجلسة معلنه لأطراف الدعوى، محدده بتاريخ 24/ 06/ 2025م، لتنظر المحكمة في طلب التدخل المقدم من دولة صربيا للإنضمام في الدعوى.
6. حذف القضية من القائمة العامة للمحكمة لصالح حسن سير العدالة، لإعتبار بقاء القضية في سجل القائمة العامة للمحكمة كسابقة قضائية من المحكمة، لا يسهم في حسن سير العدالة؛ لأن الحذف لا يتفق مع سلطة المحكمة للفصل في القضية وفقاً لمبادئ العـدل والإنصاف وفقاً لمعايير حذف القضية من سجل القائمة العامة للمحكمة، والذي يلزم شرط موافقة أطراف الدعوى على ذلك في مراحل تقديم وتبادل المذكرات الهجومية والدفاعية في الإدعاء والتعقيب.
7. مقدمات التسبيب التحييثي للحكم القضائي، لا يتناسب ولا يتوافق مع نهايات الحكم القضائي، المنتهية خاتمته، برفض الدعوى، وحذفها من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ وذلك لتقرير المحكمة إبتدءاً، خطورة ما يجري في السودان من أفعال الإبادة الجماعية في غرب دارفور الواقعة على إثنية قبيلة المساليت السودانية، لقول المحكمة في التحييث التسبيبي للحكم، أن أفعال الإبادة الجماعية تقع في سياق صراع مستمر منذ تاريخ 15 أبريل 2023م، وأن وقائع أحداثها بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع؛ ولذلك المحكمة أعربت عن قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان التي تشكل خلفية النزاع الحالي القائم في السودان؛ مما يعني ذلك، قناعة المحكمة بوقوع جريمة إبادة جماعية في السودان، ووجود أساس يمكن للمحكمة أن تؤسس عليه ولايتها القضائية، تبعاً لمبدأ الإختصاص المستمد من قواعد الاختصاص في القانون الدولي على الرغم من وجود التحفظ على الإختصاص؛ وبالتالي، من التسبيب التحييثي للحكم، نستنتج أن أحكام القانون الدولي ظاهرياً تمنح المحكمة إختصاصاً ظاهر بأنها محكمة مختصة بنظر الدعوى إبتداءاً، وأن تصدر المحكمة قراراً في التدابير الوقتية الإحتياطية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، لحين البت الموضوعي النهائي في الدعوى.
ولذلك، يقتضي متابعة النصوص الجوهرية الأساسية في القانون الدولي، وإنزالها على حيثثيات الحكم القضائي للمحكمة، ودون إسهاب أو إيجاز، نحاول أن نشير لها على النحو الآتي:
(أولاً) قواعد نصوص القانون الدولي:
الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، والفقه والعرف الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، مصادر لقواعد القانون الدولي وتطوره بما يحفظ حياة البشرية والأمن والسلم والتعاون الدولي بين الدول وحماية حقوق الإنسان. فهي بذلك قواعد قانون، تشير وتكشف صراحة وضمناً، قواعد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية للبت بالنظر في المنازعات والصراعات المختلفة بين الدول، وتعمل على تعزيز وحماية البشرية من ويلات المآسي المتعددة الإصطناعية التي تقع وتحدث بفعل الإنسان.
(أ) ميثاق الأمم المتحدة 1945م والنظام الأساسي للمحكمة 1945م ولائحة المحكمة 1978م:
1. إختصاص محكمة العدل الدولية نصت عليه المواد 92 - 94/(1) من ميثاق الأمم المتحدة 1945م، بأن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وأن جميع أعضاء الأمم المتحدة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ ويتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة، أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
2. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945م، المواد 34 – 38، 40، 41، 57، 60، 61، 73 – 78، 81 - 86 من النظام الأساسي للمحكمة تضمنت نصوص أحكام بإختصاص المحكمة، بأن للدول وحدها الحق أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة، وأن الدول التي هي أطراف في النظام الأساسي أن تتقاضى أمام المحكمة؛ وأن ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليهـا المتقاضون، كمـا تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفـة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والإتفاقيات المعمول بها؛ وطبقاً للمادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، شروط ثلاثة يجب توفر إحداها، لكي يكون للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى المقامة أمامها، والشروط الثلاثة هي:
(1) موافقة الدولتين على إحالة القضية إليها، أو؛
(2) أن تكون الدولة المدعى عليها قد تقدمت بموافقة مسبقة بصلاحية المحكمة، أو؛
(3) وجود إتفاقية دولية تحدد إختصاص محكمة العدل الدولية في حال وجود نزاع متعلق في تفسير وتطبيق وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات.
ومن ما تضمنته قواعد القانون الدولي، وظيفـة المحكمة الفصل في المنازعـات التي ترفـع إليهـا وفقـاً لأحكام القانون الدولي؛ والمحكمة في هذا الشأن تطبق الإتفـاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قـواعد معتـرفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ و/ أو العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الإستعمال؛ و/ أو مبادئ القانون العامـة التـي أقـرتها الأمم المتمدنة؛ و/ أو أحكام المحاكم ومـذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. وأنه من كل ما ورد أعلاه، لا يترتب علـى ما تم ذكره من قواعد وأحكام، أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية، وذلك وفقاً لمبادئ العـدل والإنصاف، متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. وأن للمحكمة إتخاذ التدابير المؤقتة التي يجب إتخاذها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب بذلك، لحفظ حق كل من الأطراف، وذلك متى رأت المحكمة، أن الظروف تقتضي بذلك، وأنه وإلى حين أن يصدر الحكم النهائي، يُبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يُرى إتخاذها. وتحدد المحكمة ما إذا كان على الأطراف أن يترافعوا قبل تقديم الأدلة أو بعد ذلك، على أن يحفظ حقهم في مناقشة هذه الأدلة.
ومن المسائل المتعلقة بإختصاص محكمة العدل الدولية، أن للمحكمة في أي وقت قبل عقد الجلسات أو أثنائها، أن تبين أي نقاط أو مسائل تود أن يوجه إليها الأطراف إهتماماً خاصاً، أو ترى أنها قد عولجت بما فيه الكفاية؛ وللمحكمة أن توجه خلال الجلسات أسئلة للوكلاء والمستشارين والمحامين، وأن تطلب منهم إيضاحات؛ وأنه لكل قاض حق مماثل في توجيه الأسئلة، ولكن عليه قبل ممارسة هذا الحق، أن يفصح عن نيته في ذلك لرئيس المحكمة الذي هو، المسؤول عن إدارة الجلسات؛ ويجوز للوكلاء والمستشارين والمحامين الإجابة إما فوراً أو في غضون أجل يحدده الرئيس؛ والمسائل المتصلة بالإجراءات العارضة والتدابير التحفظية؛ وأحكام التدخل والإنضمام في الدعوى من طرف / أطراف، بأن تعلن المحكمة الأطراف بطلب الإنضمام، للرد عليه من الأطراف، وتحديد جلسة لتقديم الردود من الأطراف، وتحديد جلسة أخرى للقرار للبت في مدى مقبولية طلب الإنضمام في الدعوى القائمة أمام المحكمة. وأن أحكام المحكمة نهائية وغير قابليته للإستئناف، فيما عدا النزاع في معنى الحكم أو في مدى مدلوله، حيث تقوم المحكمة بتفسير الحكم الصادر منها بناء على طلب أي طرف من أطراف الحكم.
3. من ما هو متعلق بالإختصاص، مباشرة إتخاذ الإجراءات الإجرائية والشكلية أمام المحكمة، نشير لأحكام قواعد لائحة المحكمة 1978م؛ أحكام رفع الدعوى المنصوص عليه في المواد 38 – 43 الدعاوى المرفوعة بعريضة، بأنه في حالة رفع دعوى للمحكمة بعريضة مقدمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 40 من النظام الأساسي للمحكمة(رفع العريضة بوساطة الوكلاء أو الممثلين وبيان عناوينهم؛ وإدعاء المدعية تجاه المدعى عليها بصحة الإختصاص، فإنه تحال العريضة إلى الدولة المدعى عليها، وحتى ذلك، لا تقيد الدعوى في الجدول العام للمحكمة، ولا يتخذ أي إجراء في الدعوى، إلى أن تقبل الدولة التي رفعت الدعوى عليها بإختصاص المحكمة في النظر في القضية)؛ ويتعين أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.
وبشأن المرافعات الخطية المنصوص عليها في المواد 44 – 53 من لائحة المحكمة، نشير لنص المادة 45 المتعلقة بالدعاوى المرفوعة بعريضة، بأن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبني عليها المدعي قوله بإختصاص المحكمة؛ كما تعين الطابع المحدد للإدعاء، وتتضمن عرضاً موجزاً للوقائع والأسس التي يقوم عليها الإدعاء؛ وفيها تتألف المرافعة من مذكرة من المدعي، تليها مذكرة مضادة من المدعى عليه، وللمحكمة أن تأذن أو تقضي بتقديم رد من المدعي، وتقديم رد من المدعى علية على رد المدعي، سواء إتفق الأطراف على ذلك، أو إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف، ثمة ضرورة لهذين الردين؛ وأن تتضمن مذكرة المرافعة الخطية عرضاً للوقائع المتصلة بالموضوع، وبياناً بحكم القانون، والاستنتاجات؛ وأن تتضمن المذكرة المضادة إعترافاً بالوقائع الواردة في المذكرة أو إنكاراً لها؛ وعند الإقتضاء عرضاً لأي وقائع إضافية؛ وإبداء ملاحظات على بيان حكم القانون الوارد في المذكرة؛ وبياناً بحكم القانون رداً عليه، والاستنتاجات؛ وينبغي ألا تكون المذكرة الجوابية (مذكرة الرد من المدعى عليه) والمذكرة التعقيبية(مذكرة التعقيب من المدعي)، إذا أذنت بهما المحكمة، أن تكون مجرد تكرار لإدعاءات الأطراف، وإنما ينبغي أن تبرزا النقاط التي لا تزال تفرق بين الأطراف، وينبغي أن تتضمن كل وثيقة من وثائق المرافعة، إستنتاجات الطرف المودع لها في المرحلة المعينة من القضية، بإعتبار ذلك شيئاً متميزاً عن إقامة الحجة، أو تأكيداً للإستنتاجات التي سبق له تقديمها؛ ونشير للمواد 81 – 86 الأحكام الخاصة بإجراءات التدخل والإنضمام في الدعوى من طرف/ أطراف ثالثه.
وعن الاختصاص نشير للمواد 98 – 100 من لائحة قلم محكمة العدل الدولية لعام 1978م فيما يتصل بطلبات تفسير الأحكام أو إعادة النظر فيها، بأنه في حالة طلب إعادة الحكم في الحكم، يقدم طلب إعادة النظر في الحكم بعريضة تتضمن البيانات اللازمة، لإثبات إستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة؛ وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة؛ وللطرف الخصم الحق في تقديم ملاحظاته الخطية على جواز قبول عريضة طلب إعادة الحكم في غضون أجل تحدده المحكمة، أو يحدده الرئيس إذا كانت المحكمة غير منعقدة؛ وأن تبلغ هذه الملاحظات للطرف الذي قدم العريضة؛ وللمحكمة قبل أن تفصل في أمر مقبولية عريضة طلب إعادة الحكم، أن تتيح للأطراف فرصة أخرى، للإعراب عن وجهات نظرهم في هذا الصدد؛ وإذا وجدت المحكمة أن عريضة طلب إعادة الحكم مقبولة، قامت بعد التحقق من وجهات نظر الأطراف، بتحديد آجال للإجراءات الأخرى التي تراها ضرورية للفصل في موضوع العريضة؛ وإذا قررت المحكمة أن يكون فتح باب إجراءات إعادة النظر مرهونا بالتنفيذ المسبق للحكم، أصدرت أمراً بهذا المعنى يقضي بوقف أثر الحكم حسبما يقتضيه الحال.
(ب) إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م:
عن ذات الإختصاص لمحكمة العدل الدولية، فإنه عملاً بأحكام المواد 2 ،3، 9 من إتفاقية منع جريمة الابادة
الجماعية 1948م، نشير لأحكام الإتفاقية الخاصة، بتعريف الإبادة الجماعية، ومعاقبة طائفة الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، بمعاقبة أياً من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بما يفضي إلى قتل أعضاء من الجماعة؛ و/ أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ و/ أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ و/ أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ و/ أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. ومعاقبة أي من أفعال الإبادة الجماعية؛ و/ أو التآمر على إرتكاب الإبادة الجماعية؛ و/ أو التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية؛ و/ أو محاولة إرتكاب الإبادة الجماعية؛ و/ أو الإشتراك في الإبادة الجماعية.
ومن نصوص الإتفاقية، المادة الثالثة منها، هي مثار الإختصاص لمحكمة العدل الدولية، بالنسبة للدول كفاعل يتحمل مسئولية إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لما على الدول من واجب الوفاء بإلتزامتها التعاقدية لضمان منع إنتهاكات الإلتزامات الأساسية في القانون الدولي، والتي منها المنع والحدّ من إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ولبيان الإختصاص الصريح والمباشر لمحكمة العدل الدولية النظر والبت القضائي في جريمة الإبادة الجماعية، تنص الإتفاقية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الإتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الإتفاقية(تعريف الإبادة الجماعية والأفعال المعاقب عليها).
(ج) إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م:
بمقتضى إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م، تقنيات وأدوات تحديد الإختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، تحدده إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، بحسبما نصت عليه المادة(1/ د): تعريف كلمة التحفظ(بأنه إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة). وكذلك المادة 19/(ج) والذي ينص على أن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الإتفاقية وغرضها. كما أن إختصاص المحكمة تحدده قواعد الإنضمام للإتفاقية الوارد في المادة 1/(ب) بأنه: يقصد بـالتصديق والقبول والموافقة والإنضمام، الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تَقرّ الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الإلتزام بالمعاهدة، وأحكام عقد المعاهدات المنصوص عليها في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فيما يتعلق بأدوات ووسائل التعبير بالإنضمام للإتفاقية؛ وأحكام بطلان المعاهدات وبطلانها وإيقاف العمل بها، فيما يتعلق بأدوات ووسائل الإنسحاب من الإتفاقية. وعملياً، الطعن في التحفظ، كدفع من القانون، أمر يثير ويطرح، مسألة التحفظ وأثره من حيث تأثير التغيرات الجوهرية على المعاهدة الدولية المنصوص عليها في المادة 62(/1/ب) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية؛ قاعدة التغيير للظروف، وقاعدة شرط بقاء الشئ على حاله؛ تبعاً للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الدول. وعلاوة على الجوانب الموضوعية لمقبولية التحفظات، فإنه لقبول التحفظ، يجب أن يراعي التحفظ الشروط الشكلية المحددة له، للتعبير عنه كتابة، ببيانه مفصلاً، دونما إبهام أوغموض، أو تعميم، أو أن تكون صيغة التحفظ الكتابية تعبيراً وبياناً له، هلامياً أو فضفاضاً. والشروط الشكلية للتحفظ، تتمثل بإيجاز في الآتي:
(1) يجب أن يكون التحفظ مكتوباً، حتى يمكن إبلاغه رسمياً للأطراف الأخرى في المعاهدة، بإرسال نسخة من أصل التحفظ للأمين العام للأمم المتحدة، لإيداعة ضمن وثائق الإتفاقية، وإخطار الدول الأعضاء الطرف، ويمتد هذا الشرط، ليشمل القبول الصريح للتحفظ، أو الإعتراض عليه، وسحب التحفظ.
(2) أن يكون التحفظ دقيقاً، ومحدد الموضوع والمحل والسبب؛ فلا يجوز إبداء تحفظات ذات طابع عام، دونما تحديد له، حيث لا يسمح بالتحفظ الذي تتم صياغته بألفاظ واسعة.
(3) أن يوضح التحفظ من الدولة المتحفظة، الأسباب الموضوعية الذي بنت عليه الدولة المتحفظة التحفظ، كمثال: أن المادة المتحفظ عليها من الإتفاقية، تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة والقانون الوطني المحلي للدولة المتحفظة. أو؛ أن المادة المتحفظ عليها، تتعارض مع القيم المعتبرة المقبولة السائدة في مجتمع الدولة المتحفظة. أو؛ أن المادة المتحفظ عليها تتعارض مع القيم الدينية والروحية المعتقدية للدولة المتحفظة.
(4) أن تكون الترجمة الكتابية اللغوية في نسختها الورقية الأصلية المودعة عند الأمين العام للأمم المتحدة، ترجمة لغوية واحدة، ومطابقة لمضمون موضوع الإتفاقية، وحيث لا يُعتد ولا يُعترف، بوجود أكثر من نسخة مترجمة للتحفظ.
وفي الواقع التشريعي للقانون، يتيح التحفظ للدولة، أن تكون طرفاً في المعاهدة، مع إستبعاد الأثر القانوني للحكم المحدد الوارد في الإتفاقية التي تعترض عليه الدولة المتحفظة متى ما توافرت وتحققت أسبابه. ولدواعي إزالة ورفع آثار التحفظ على الدولة المتحفظة وعلى الدولة الغير الطرف في الإتفاقية، فإنه وطبقاً للمادة 14 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948م، تكون الإتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ بدء نفاذها. وأنها تظل بعد ذلك الإتفاقية نافذة المفعول لفترات متعاقبة، تمتد كل منها خمس سنوات، إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد إنسحبوا منها قبل إنقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل. الأمر الذي يتيح للدولة المتحفظة أو المتأثرة من التحفظ، الإنسحاب من الإتفاقية، لدواعي موجبات أسباب التحفظ إبتدءاً. وكما أنه لا يمكن للدول إبداء تحفظات بعد قبولها للإتفاقية؛ ويجب إبداء التحفظ في الوقت الذي تؤثر فيه الإتفاقية على الدولة المتحفظة.
وواقع عملي، إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، لم تخلق مفهوم التحفظات؛ ولكن قبول التحفظ من عدمه، يحكمه قواعد القانون العرفي المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بأن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الإتفاقية التعاهدية. ولذلك، يدخل في إختصاص محكمة العدل الدولية، تقويم وفحص مدى صحة التحفظات مقبوليتها، ومدى إتفاقها مع موضوع المعاهدة وغرضها. وذلك لأن من شان التحفظات، أن يحول دون التطبيق الفاعل والمتكامل لأحكام الإتفاقية، وكما قد يؤدي إلى إضعاف إحترام الدول لإلتزاماتها التعاقدية والتعاهدية، فمن باب أولى وعدالة، للدولة المتحفظة أو الدولة المتأثرة من التحفظ، الإنسحاب من الإتفاقية طبقاً للمادة 14 من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. لأن من شأن التحفظات بالنسبة للدولة المتحفظة، أن يَخلّ بإلتزاماتها الدولية التعاقدية. وفي هذا الصدد، كان لمحكمة العدل الدولية دور جيد في ممارسة الإختصاص، والذي تجسد بشكل مباشر في الرأي الإستشاري الذي أبدته في 28/ 5/ 1951م، بشان قضية التحفظات على إتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري(جريمة الإبادة الجماعية). وكما محكمة العدل الدولية، أعادت التأكيد على الإختصاص، وإن كان بشكل غير مباشر في قضية الجرف القاري لبحر الشمال في قرارها الصادر في 20/2 / 1969م.
(ثانياً) الدراسة والتعليق:
من مستخلص الفروض السبعة، بشأن الحكم القضائي لمحكمة العدل الدولية، برفض دعوى جمهورية السودان ضد الامارات العربية المتحدة، لعدم اختصاص المحكمة، والقاضية في حكمها النهائي، برفض طلب التدابير الوقتية الوقائية، ورفض الدعوى لعدم الإختصاص، والأمر بشطب الدعوى من سجل القائمة العامة لمحكمة العدل الدولية. نحاول تناول الفروض السبعة كل على حدى، بالتعليق عليها.
1. قبول الدعوى للبت في التدابير الوقتية الطارئة المقدم من جمهورية السودان، يحكمها مبادئ قواعد الإختصاص المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحده 1945م والنظام الأساسي للمحكمة 1945م ولائحة المحكمة 1978م وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، تبعاً لمبدأ لمبادئ الإختصاص، وذلك لضمان منع إنتهاكات الإلتزامات الأساسية المقررة في القانون الدولي، لأنها إلتزامات تقع على عاتق جميع الدول تجاه المجتمع الدولي ككل (erga omnes partes doctrine). ودواعيه وضروراته، حماية البشرية من ويلات المآسي التي يتسبب فيها الإنسان، لخطورة جريمة الإبادة الجماعية على حياة الإنسانية، وللمحافظة على الأمن والسلم الدوليين المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 1945م، ولتعزيز التعاون الدولي بين الدول لحماية حقوق الإنسان؛ ولمنع إرتكاب أفعال جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ بوسائل إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي 1945م وقواعد المحاكمة في لائحة المحكمة 1978م، وهو الغاية والهدف والغرض من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، بأن لا يكون التحفظ المنصوص عليه في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م منافياً لموضوع إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م؛ وبالتالي، طلب التدابير الوقتية الطارئة المقدم من جمهورية السودان، أن تتخذ الأمارات العربية المتحدة من التدابير والإجراءات بما يمنع من وقوع جريمة الإبادة الجماعية على قبيلة إثنية المساليت السودانية، وأن لا تدعم وأن لا تقوم الأمارات العربية المتحدة بتقديم أي تسهيلات من أي نوع بتقديمها لمليشيا الدعم السريع الشبه عسكريه، وذلك إلى حين، البت الموضوعي النهائي في الدعوى.
وعليه، اتخاذ التدابير الوقتيّة الاحترازية من قبل محكمة العدل الدولية في إطار إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م يرتبط بإختصاص المحكمة الوارد في الإتفاقية نفسها طبقاً لنص المادة التاسعة من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ بأن تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق الإتفاقية؛ ففي هذه الحالة، إختصاص محكمة العدل الدولية، يأتي من الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومن ميثاق الأمم المتحدة 1945م والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945م وقواعد لائحة المحكمة 1978م وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، وتبعاً لمبادئ الاختصاص المستمدة من قواعد الاختصاص في القانون الدولي على الرغم من وجود التحفظ؛ والمبادئ أرستها أحكام محكمة العدل الدولية وفقهاء القانون؛ وبما تنتهي إليه المحكمة من إجراءات المحاكمة أمامها في مسألة التحفظ، ومدى أثره على تطبيق الإتفاقية، أن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الإتفاقية من الحالة الوقائعية والقانونية لدواعي وأسباب التحفظ.
بالتالي، يمكن لمحكمة العدل الدولية إتخاذ تدابير وقتيّة إحترازية في إطار إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لحماية حقوق الأطراف وحفظ السلام والأمن الدوليين؛ وهو ما إنتهت إليه المحكمة لتقريرها إبتدءاً، خطورة ما يجري في السودان من أفعال الإبادة الجماعية في غرب دارفور على إثنية قبيلة المساليت السودانية، لقول المحكمة في التحييث التسبيبي للحكم، أن أفعال الإبادة الجماعية في السودان تقع في سياق صراع مستمر منذ تاريخ 15 أبريل 2023م، وأن وقائع أحداثها الوقائعية بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع؛ ولإعراب المحكمة عن قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان التي تشكل خلفية النزاع الحالي القائم في السودان؛ مما يعني ذلك، قناعة المحكمة بوقوع جريمة إبادة جماعية في السودان؛ وأنة من الحالة القانونية لطبيعة الصراع الدائر في السودان، يستخلص أن هناك وجود أساس يمكن للمحكمة أن تؤسس عليه ولايتها القضائية بنظر الدعوى؛ مما يعني ذلك من التسبيب التحييثي للحكم، إستنتاج أن أحكام القانون الدولي ظاهرياً وفقاً لمبدأ الإختصاص على الرغم من وجود التحفظ، يمنح محكمة العدل الدولية إختصاصاً ظاهراً، بأنها محكمة مختصة بنظر الدعوى إبتداءاً، وأن تصدر المحكمة قراراً في التدابير الوقتية الإحتياطية، لمنع جريمة الإبادة الجماعية، لحين البت الموضوعي النهائي في الدعوى.
2. الإختصاص المنصوص عليه في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، هي نقطة نزاع أساسية وجوهرية في الدعوى المقامة من جمهورية السودان ضد الأمارات العربية المتحدة، مما يتطلب ذلك، البت في مسألة الإختصاص من الحالة الواقعية والقانون، بأن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الإتفاقية وغرضها؛ لتقديم ممثلي الأمارات العربية المتحدة ثلاثة مستندات على زعم أنها صيغة التحفظ المنصوص عليه في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م؛ والمستندات المقدمة للمحكمة أنها التحفظ المكتوب، ومنها مستند مكتوب باللغة العربية، وإثنين باللغة الإنجليزية، وبينها خلط وتناقض في الترجمة اللغوية؛ ولطرح المحكمة سؤال مباشر على ممثلي الأمارات العربية المتحدة، بيان سبب التحفظ على إختصاص محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م.
بالتالي، من ما إنتهت إليه المحكمة في تسبيبها التحييثي للحكم، يبدو جلياً عدم إلتفات المحكمة لأسباب ودواعي التحفظ، وعدم طرح مناقشته وفقاً لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، مما يُعد ذلك قصوراً في التسبيب التحييثي للحكم، ويبطل الحكم، للإعتبارات الآتية:
(1) الجوانب الموضوعية لمقبولية التحفظات المنصوص عليه في المادة 19/(ج) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، أن لا يكون التحفظ منافياً لموضوع الإتفاقية.
(2) لقبول التحفظ، يجب أن يراعي التحفظ الشروط الشكلية المحددة له، للتعبير عنه كتابة للتدليل والتعويل على سلامة صحته، ببيانه مفصلاً، دونما إبهام أوغموض، أو تعميم، أو أن تكون صيغة التحفظ الكتابية تعبيراً وبياناً له، هلامياً أو فضفاضاً؛ وفي هذا الصدد، نشير للشروط الشكلية لمقبولية التحفظ، من حيث الجوانب الشرطية الآتية:
(أ) يجب أن يكون التحفظ مكتوباً، حتى يمكن إبلاغه رسمياً للأطراف الأخرى في المعاهدة، بإرسال نسخة من أصل التحفظ للأمين العام للأمم المتحدة، لإيداعة ضمن وثائق الإتفاقية، ونشره بإخطار الدول الأعضاء الطرف، ويمتد هذا الشرط، ليشمل القبول الصريح للتحفظ، أو الإعتراض عليه، وسحب التحفظ.
(ب) أن يكون التحفظ دقيقاً، ومحدد الموضوع والمحل والسبب؛ فلا يجوز إبداء تحفظات ذات طابع عام، دونما تحديد له، حيث لا يسمح بالتحفظ الذي تتم صياغته بألفاظ واسعة.
(ج) أن يوضح التحفظ من الدولة المتحفظة، الأسباب الموضوعية الذي بنت عليه الدولة المتحفظة التحفظ، كمثال: أن المادة المتحفظ عليها من الإتفاقية، تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة والقانون الوطني المحلي للدولة المتحفظة. أو؛ أن المادة المتحفظ عليها، تتعارض مع القيم المعتبرة المقبولة السائدة في مجتمع الدولة المتحفظة. أو؛ أن المادة المتحفظ عليها تتعارض مع القيم الدينية والروحية المعتقدية للدولة المتحفظة.
(د) أن تكون الترجمة الكتابية اللغوية في نسختها الورقية الأصلية المودعة عند الأمين العام للأمم المتحدة، ترجمة لغوية واحدة، ومطابقة لمضمون موضوع الإتفاقية، وحيث لا يُعتد ولا يُعترف، بوجود أكثر من نسخة مترجمة للتحفظ.
عليه من الوهلة الأولي، من تقديم الأمارات العربية المتحدة ثلاثة نسخ بصيغة مكتوبة متعددة، يثبت ويبدو جلياً، عدم صحة وسلامة تحفظ الأمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، لتدفع بحُجة نزع إختصاص المحكمة. وأنه طبقاً لقواعد إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 1945م وميثاق تأسيس محكمة العدل الدولية 1945م وقواعد لائحة المحكمة 1978م، يبدو جلياً سوء سلوك الأمارات العربية المتحدة أمام المحكمة، وسوء نوايها تجاه جمهورية السودان، لتقديمها ثلاثة نسخ للتحفظ المكتوب على زعم أنه التحفظ على المادة التاسعة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وتبعاً عليه، وجود ثلاثة نسخ مكتوبة للتحفظ، يفرغ التحفظ من مضمونه، للدفع بالتحفظ حُجة في المقبولية له في الإثبات؛ وكما أن المحكمة لم تطرح أو تناقش أثر تقديم أو وجود ثلاثة نسخ مكتوبه للتحفظ الذي تقدمت به الأمارات العربية المتحدة، للتدليل والتعويل عليه، أنه التحفظ المكتوب طبقاً لأحكام إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م؛ مما يُعد ويُعتبر ذلك، قصوراً مخل بإجراءات المحاكمة، وأن يكون سبباً لبطلان الحكم.
وبالتالي عملياً قضائياً، يتعين على المحكمة سماع حجج وأسانيد الأطراف، قبل إتخاذ أي قرار بشأن رفض الدعوى وشطبها من سجل القائمة العامة للمحكمة، لأن وجود التحفظ، يجعل من إختصاص محكمة العدل الدولية أن يكون الإختصاص محل نزاع (نقطة نزاع أساسية وجوهرية). ولذلك، يمكن القول، أن رفض محكمة العدل الدولية الدعوى، والأمر بشطبها من سجل المحكمة، بعد الإستماع إلى المذكرات الشفاهية والمكتوبة، وبعد طرح المحكمة الأسئلة على ممثل الأمارات العربية المتحدة من جانب أعضاء المحكمة عن أسباب التحفظ، وسبب تقديم ثلاثة مستندات مكتوبة بأنه التحفظ على إختصاص محكمة العدل الدولية، طبقاً لنص المادة التاسعة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م؛ ودون بيان الحكم من التسبيب التحييثي له، مناقشة المحكمة للتحفظ من الناحية الوقائعية والقانونية، سواء من حيث تساؤلات أسباب التحفظ، وتساؤلات سبب تقديم ثلاثة نسخ مكتوبة للمحكمة، بأنه التحفظ المكتوب؛ بلا شك، هو أمر، يثير العديد من التساؤلات حول مدى ملاءمة قرار محكمة العدل الدولية، لأن منطق عقل الواقع يقرر أنه وقبل إتخاذ أي قرار يجب على المحكمة النظر في الإجابات المقدمة لممثل الأمارات العربية المتحدة، والإشارة لقيمتها القانونية عند تسبيب الحكم، وهو ما يوضحة الحكم.
3. قواعد الإختصاص المنصوص عليها في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، يتطلب فيها من المحكمة السماع الخاص بدراسة مذكرات مرافعات الأطراف لإستنتاج الجوانب القانونية للتحفظ وأسبابه، والسماع العام بتقديم وتحليل المستندات، لتستخلص المحكمة من المستندات أسباب التحفظ ودواعية، لتتمكن المحكمة من الوقوف على مدى سلامة وصحة التحفظ المقرر وفق إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، والبت السليم في التحفظ من حالته الوقائعية والقانون.
وعن هذه الفرضية من التحليل لحكم محكمة العدل الدولية، إغفال الجوانب الإجرائية للإثبات في المحاكمة، مؤداه قصور في الحكم، وسبب كافي لبطلانه؛ وأنه من الجوانب الوقائعية والقانونية للتحفظ على نحو ما ذُكر، فإن أي تفسير أو تأويل له، لا يتسم مع منطق وعقل الواقع والقانون، سبب كافي في سوء تطبيق القانون، ومؤداه قصور الحكم وبطلانه؛ لأنه يتعين على المحكمة، أن تدرس نطاق التحفظ، ومدى تأثيره على إختصاصها؛ لإعتبارات التحفظ وجواز التحفظ، لم يُنص عليها صراحة وبطريق مباشر في نص المادة التاسعة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، لكيما يستثني التحفظ صراحةً إختصاص المحكمة؛ ولا سيما نص المادة التاسعة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، تنص على إختصاص المحكمة في النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، وبذلك، يكون للمحكمة إختصاص النظر في الدعوى، ولو على إفتراض وجود التحفظ.
مما يعني ويفيد التحليل، أن القانون الدولي، يشدد على أهمية تفسير المحكمة، لنطاق التحفظ، ومدى تأثيره على إختصاصها، نظراً فيه من جوانبة الوقائعية والقانونية. ولذلك، يدخل في إختصاص محكمة العدل الدولية، تقويم وفحص مدى صحة التحفظات ومقبوليتها، ومدى إتفاق التحفظات مع موضوع المعاهدة وغرضها؛ لأنه من شأن التحفظات، أن يحول دون التطبيق الفاعل والمتكامل لأحكام الإتفاقية؛ وكما قد يؤدي إلى إضعاف إحترام الدول، لإلتزاماتها التعاقدية والتعاهدية المقررة في الإتفاقيات التعاهدية.
4. طلب الإجراءات التحفظية المقدم من جمهورية السودان، تقتضيه دواعي الغرض من ميثاق الأمم المتحدة 1945م وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، لضرورة الحفاظ على نوع الجنس البشري، ولدواعي حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول، وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وهذه الفرضية في تحليل الحكم، لأنه من حيث الموضوع، وبحسبما أشارت له المحكمة في مستهل التسبيب التحييثي للحكم، إقتباساً وإستعارة منه، بما يتناسب مع التحليل، قول المحكمة، أن أفعال الإبادة الجماعية في السودان، تقع في سياق صراع مستمر منذ تاريخ 15 أبريل 2023م؛ وأن وقائع أحداثها الوقائعية تدور بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع؛ ولذلك، نجد أن المحكمة أعربت عن قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان - التي بحسب قول المحكمة - أنها تشكل خلفية النزاع الحالي القائم في السودان؛ مما يعني ذلك، قناعة المحكمة بوقوع جريمة إبادة جماعية في السودان، وأنة من الحالة القانونية لطبيعة الصراع الدائر في السودان، يوجد أساس يمكن للمحكمة أن تؤسس عليه ولايتها القضائية بنظر الدعوى؛ بالقدر الذي يحقق الغرض من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأن تصدر المحكمة أوامر الإجراءات التحفظية اللازمة والكافية المقررة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة 1945م والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945م وقواعد لائحة المحكمة 1978م، بأن تتخذ الأمارات العربية المتحدة من التدابير والإجراءات، بما يمنع من وقوع جريمة الإبادة الجماعية على قبيلة إثنية المساليت السودانية؛ وأن لا تدعم وأن لا تقوم الأمارات العربية المتحدة، بتقديم أي تسهيلات لمليشيا الدعم السريع الشبه عسكريه، وذلك إلى حين البت الموضوعي النهائي في الدعوى.
5. الحكم القضائي الصادر من محكمة العدل الدولية، لم يبت بقرار صادر من المحكمة في مقبولية طلب الإنضمام والتدخل في الدعوى المقدم من دولة صربيا بتاريخ 24 أبريل 2025م، وحيث يمثل جمهورية صربيا البروفيسور ألكسندر غايتش (دكتوراه في القانون الدولي)، بصفته المستشار القانوني الأول في وزارة الخارجية الصربية، وبصفته وكيلاً للدولة؛ ورغماً عن ذلك بتاريخ 05/ 05/ 2025م المحكمة أصدرت الحكم في الدعوى برفضها، والأمر بشطبها من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ على الرغم من تحديد المحكمة لجلسة معلنه لأطراف الدعوى محدده بتاريخ 24/ 06/ 2025م، لتنظر المحكمة في طلب التدخل المقدم من دولة صربيا.
هذه الفرضية تبين وتوضح، أنه بعد رفض الدعوى وشطبها، يصبح طلب الإنضمام المقدم من دولة صربيا، أنه ما زال محل نزاع قائم، لم تبت فيه المحكمة، لأنه لم يتم النظر فصلاً قضائياً فيه من جانب المحكمة؛ وبالتالي، مؤداه بطلان الحكم القضائي لمحكمة العدل الدولية مثار الدراسة والتحليل؛ لإعتبار النظر في طلب الإنضمام المقدم من دولة صربيا من أولويات المسائل المستعجلة، وكان يجب على المحكمة النظر فيه قبل، رفض الدعوى، وشطبها من سجل القائمة العام المحكمة؛ لأن في إخطار الأطراف بجلسة تالية للنظر في طلب الانضمام، يشير إلى أن المحكمة كانت تنوي النظر في الطلب؛ ولكن رفض الدعوى وشطبها من جهة، أثر على إجراء الإنضمام والتدخل في الدعوى؛ وأنه يؤثر من جهة أخرى على سلامة وصحة حكم المحكمة؛ مما يعني ذلك، في كل الأحوال، بطلان الحكم القضائي.
6. حذف القضية من القائمة العامة للمحكمة لصالح حسن سير العدالة، تدبير قضائي لا يسهم في حسن سير العدالة، لإعتبار بقاء القضية في سجل القائمة العامة للمحكمة، لأنه حكم قضائي، وسابقة قضائية في الأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية، يُستشهد ويُستهدي بها في دعاوى مماثلة مستقبلاً؛ لأنه وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945م وقواعد لائحة المحكمة، حذف القضية من سجل القائمة العامة للمحكمة، لا يتفق مع سلطة المحكمة للفصل في القضية وفقاً لمبادئ العـدل والإنصاف، الذي يلزم شرط موافقة أطراف الدعوى على ذلك في جميع مراحل تقديم وتبادل المذكرات الهجومية والدفاعية في الإدعاء والتعقيب. ونظراً إلى أن التدبير القضائي مثار التحليل، لا مرجعية قضائية له من المذكرات المتبادلة بين أطراف الدعوى بياناً له بما يفيد الموافقة قبولاً بمبادئ العدل والإنصاف، لإعمال سلطة المحكمة في الحذف للقضية من سجل القائمة العام للمحكمة.
وحيث حذف القضية من سجل القائمة العامة للمحكمة، تقتضيه معايير خاصة، وعلى سبيل المثال؛ عدم وجود نزاع حقيقي بين أطراف الدعوى، بمعنى ليس هناك نزاع حقيقي بين الأطراف، أو أن النزاع قد تم حله بالفعل؛ وعدم وجود مصلحة قانونية للأطراف في النزاع، أي ليست لدى الأطراف مصلحة قانونية في النزاع، أو أن المصلحة القانونية زالت؛ وعدم وجود أساس قانوني، بأن ليس هناك أساس قانوني للإدعاءات المقدمة، أو أن الإدعاءات لا تستند إلى أي أساس من القانون؛ وإتفاق الأطراف على إنهاء الدعوى، بأن يتفق الأطراف على إنهاء الدعوى. وحيث المحكمة في حكمها لم تنظر في جميع الجوانب القانونية والواقعية؛ ولم تلتزم بالإجراءات المعمول بها في إجراءات المحاكمة؛ فإن مؤدي الحكم بحذف القضية بحكم قضائي، يشوبه شائبة عدم وجود أساس له من الواقع والقانون؛ وبالتالي، بطلان الحكم .
7. مقدمات التسبيب التحييثي للحكم القضائي، لا تتناسب ولا يتوافق مع نهايات الحكم القضائي، المنتهية خاتمته برفض الدعوى وحذفها من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ وذلك لتقرير المحكمة إبتدءاً، خطورة ما يجري في السودان من أفعال الإبادة الجماعية في غرب دارفور الواقعة على إثنية قبيلة المساليت السودانية، لقول المحكمة في التحييث التسبيبي للحكم، أن أفعال الإبادة الجماعية في السودان تقع في سياق صراع مستمر منذ تاريخ 15 أبريل 2023م، وأن وقائع أحداثها بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع؛ ولذلك المحكمة أعربت عن قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان التي تشكل خلفية النزاع الحالي القائم في السودان؛ مما يعني ذلك، قناعة المحكمة بوقوع جريمة إبادة جماعية في السودان، ووجود أساس يمكن للمحكمة أن تؤسس عليه ولايتها القضائية بنظر الدعوى والفصل فيها موضوعاً وشكلاً؛ لشواهد الأدلة التي قدمتها جمهورية السودان في عريضة شكواها ومذكراتها المتبادلة، بالقدر الذي جعل المحكمة في قرارها تشير صراحة إلى قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والصراع العنيف وآثاره المدمرة التي تسفر عن خسائر في الأرواح، ومعاناة لا تحصى، لاسيما في غرب دارفور.
إلا أنه، ورغماً عن وصول المحكمة لهذه القناعة، رأت عدم إختصاصها، علماً بأن هنالك دعاوي مشابهة، وعلى سبيل المثال، نشير للدعوى بين جنوب أفريقيا وإسرائيل قيودات سجل القائمة العامة للمحكمة بالرقم:
192 - Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel حيث في هذه القضية، قدمت جنوب أفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023م، إدعت جنوب افريقيا أن إسرائيل إنتهكت إلتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، وأنه يجب على المحكمة إتخاذ تدابير مؤقته لوقف الهجمات المستمرة على الفلسطينيين؛ والمحكمة رغم وجود تحفظ، نظرت في الطلب، وأصدرت حكماً أولياً في القضية لصالح جنوب أفريقيا.
وكذلك في قضية غامبيا ضد ميانمار في عام 2019م، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بإنتهاكات ميانمار لإلتزاماتها الدولية بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م؛ وهذه القضية إستخدمت مفهوم erga omnes partes، الذي يعني أن الإلتزامات الأساسية في القانون الدولي مثل حظر جريمة الإبادة الجماعية، هي إلتزامات تقع على عاتق جميع الدول تجاه المجتمع الدولي ككل؛ أي المفهوم وعلى الرغم من وجود التحفظ، يسمح لأي دولة طرف في الإتفاقية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه دولة أخرى، ودواعيه، لضمان منع إنتهاكات الإلتزامات الأساسية في القانون الدولي مثل حظر جريمة الإبادة الجماعية.
وبالتالي، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 1945م والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945م وقواعد لائحة المحكمة 1987م وإتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، ومبادئ القانون الدولي المرعية والمقبولة في الإختصاص والسوابق القضائية الإسترشادية المتماثلة المقررة لمبادئ الإختصاص رغم وجود التحفظ، وبحسب الحالة الوقائعية والقانونية لطبيعة وشرح النزاع في الدعوى بالعريضة المقدمة من جمهورية السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، سجل قيودات قلم محكمة العدل الدولية، ومن ظاهر حجج وأسانيد المذكرات الشفاهية والمكتوبة؛ نجد أحكام قواعد القانون الدولي تمنح المحكمة إختصاصاً ظاهراً تبعاً لمبادئ الإختصاص المقررة في القانون الدولي، لضمان منع إنتهاكات الإلتزامات الأساسية في القانون الدولي، بأن محكمة العدل الدولية محكمة مختصة بنظر الدعوى إبتداءاً في الشكوى والطلبات المقدمة من جمهورية السودان في مواجهة الأمارات العربية المتحدة؛ بأن تصدر المحكمة قراراً بالإختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م، وأن تصدر قراراً في التدابير الوقتية الإحتياطية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، لحين البت الموضوعي النهائي في الدعوى، والفصل في طلب الإنضمام والتدخل في الدعوى المقدم من دولة صربيا.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، المحكمة رفضت الدعوى، وأصدرت أوامرها بحذف الدعوى من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ وبالتالي، مؤدى الحكم البطلان، لمخالفة التسبيب لمنطق الواقع وعقل القانون؛ لأن الواضح من حيثييات الحكم وتسبيبه، أنه شاب الحكم خطأ جسيم في التسبيب، والخطأ الواضح في تفسير القانون، والخطأ في تقدير الوقائع، والخطأ في الربط بين الوقائع والقانون، وإغفال ذكر الأدلة في الحيثيات.
(ثالثاً) الخاتمة والخلاصة:
نخلص إلى نتيجة مؤداها، وجود عيوب جسيمة في الحكم، مما يعني بطلانه؛ لاسيما عدد 14 عضو من أعضاء المحكمة، يرفض إصدار أوامر التدابير المؤقته، وأن عدد إثنين قاضي، يرى أن تأمر المحكمة بالتدابير المؤقته؛ وأن عدد 9 قاضي يأمر برفع القضية من سجل القائمة العامة للمحكمة، وأن عدد 7 قاضي يرفض رفع القضية من سجل القائمة العامة للمحكمة.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون والموثق
11 مايو 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات